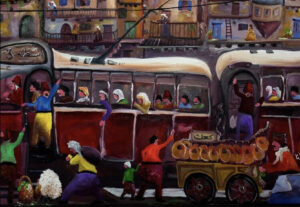في رواية «إنهم حقًا رجال شرفاء»، نكتشف الماضي الذي ينفتح مع حكي أم علياء عن حياتها وأسرتها، حيث نرى العلاقات بين الرجال والنساء، وتضامن النساء معًا، في رواية رائعة للكاتبة المصرية ابتسام شوقي.

أم علياء
١
أكره هذا الجسد. لم يسعني يومًا، لم يسعفني يومًا، لم يتصرف يومًا كما تريد الروح التي يحبسها في داخله.
حبس طفلة تحب الحياة داخل حيز بدين يُعجزها عن الحركة ويثير سخرية جميع من يراها، حبس شابة تريد أن تظهر جمالها في حيز غير متناسق، وأهان روح امرأة بين يدَي زوجها، ويوم أن منحها فرصة للحياة أخطأ في الاختيار.
أما الآن؛ فأصبح كصندوق صفيح أكله الصدأ، كل حركة مني تصدر أزيزًا وكأنه على وشك التفكك والانهيار! ركبتاي لا تتحملانني، ظهري يقتله النخر، رأسي ثقيل، يداي ترتعشان، صدري ضيق، معدتي تتلوى، أسناني تساقطت، شعري يكاد يختفي.
جسد شاخ؛ سبعون عامًا عاشها هذا الجسد، سبعون عامًا! لكنه يحمل بداخله روح امرأة عاشت مئات الأعوام، امرأة عجوز كما يقول جسدها، عجوز بطيئة الحركة تعيش وحيدة في شقة أرضي تتكون من غرفتين وصالة، تشغل هي منها حيز مترين فقط. شقة في حي قديم من أحياء الإسكندرية الشعبية، حكى لها أبوها النازح من الصعيد أنه من أوائل الأحياء التي بُنيت في المدينة والتي سكنها الوافدون، الباحثون عن العمل من المحافظات البعيدة التي تلفظ أبناءها.
حي لم تفارقه منذ ولادتها، فهنا تزوج والداها وهنا تزوجت هي بفارق عدة شوارع وعدد من الأدوار السكنية.
والداها سكنا غرفتين وصالة في دور أخير، نافذة إحدى الغرف كانت ترى السماء ولا شيء آخر، شرفة الغرفة الأخرى مصممة
لتبدو كعلبة صغيرة، اعتادت حبس نفسها فيها والجلوس على أرضها ومطالعة السحب المتحركة فوقها.
ثم تغير القدر! أو كما يقولون: من اعتاد على شيء، يزهده ويفقد إحساسه بقيمته! لقد زهدت السماء! فتزوجت في دور أرضي وانتهت بها الحال إلى الجلوس فوق أريكة ضخمة أصبحت سريرها في غرفتها ذات النافذة الوحيدة التي تطل على الشارع. تسكن دورًا أرضيًّا لا شرفة له، لم تعرف يومًا الوقوف في شرفة لمشاهدة ما يحدث في الشارع! لكنها تسمع وترى كل ما يجري فيه من نافذتها.
أنا أسكن الشارع، هذا ما اعتدت قوله طوال حياتي.
أستيقظ كل يوم وأتساءل: لماذا أبقى حية؟ لماذا أنا حية حتى هذا اليوم؟ امرأة عجوز تجاوزت السبعين من عمرها منذ عدة أشهر، تعيش وحدها منذ ما يقارب الثلاثين عامًا أو أقل قليلًا، مات زوجها، هجرتها ابنتها الوحيدة ثم عاشت بعدهما وحيدة تمامًا! لماذا أحيا حتى الآن؟
أستيقظ وأنظر إلى بيتي الذي أصبح كجسدي؛ باليًا، مهترئًا وقديمًا.
أنظر إلى قماش المفروشات الذي تفسخ وانقطع وذاب، ألوانه بهتت. السجاد البالي الذي نسلت أطرافه، الأثاث الذي تشقق وتسوس خشبه، الحوائط التي أصبح من الصعب التعرف على لونها الأصلي، الشقوق التي ترسم منحنيات وخرائط تشرح طبيعة ما عاشه ساكنوها، الأجهزة المنزلية التي توقفت إعادة تصنيع معظمها، الأتربة التي تعلو كل شيء!
أنا أسكن الشارع ومهما حاولت؛ أتربة الشارع تكسو منزلي مهما فعلت.
مطبخي أصبحت أوانيه وأدواته وأطباقه وأكوابه ينقصها شيء ما: يد، غطاء، لون أو رونق.
أصبحت أكره وضع نظارتي لأنني أرى من خلالها الانهيار في كل شيء حولي: الأتربة التي لا تزول، قطع المفروشات، أرجل الأثاث المكسورة، أبواب الدواليب التي أعجزت النجارين عن محاولة إصلاحها، فأتأقلم لما بقي من حياتي مع رؤية ما يظهر أمامي مبعثرًا مكدَّسًا كحال الذكريات في رأسي!
أضع نظارتي عند مشاهدة التلفزيون فقط حتى أرى الترجمة على الأفلام الأجنبية التي أحب مشاهدتها؛ أحب! امرأة سبعينية
تقول أحب!
أرتدي نظارتي وأطفئ الأنوار حتى لا تقع عيناي على شيء سوى شاشة التلفزيون فقط.
أصبحت أكره الحركة في البيت، وأحب الخروج لشراء احتياجاتي. آه! ما زلت أقول أحب!
أخرج لشراء احتياجاتي وأعود لترتيبها، أصنع طعامًا منزليًّا بيدين تسكبان نصفه، أتناول طعامًا طازجًا في هذا اليوم فقط، ثم أقضي بقية أيامي أتناول طعامًا بائتًا حتى موعد خروجي التالي.
***
استيقظت اليوم بألم آخر جديد في مفاصل يدَي! أكره حقًّا هذا الجسد.
فتحت عينَي مع صوت جرس الباب! تسللت يدي إلى طقم أسناني الذي يصعب عليَّ نطق الكثير من الكلمات بسببه، ولكنه يحمي مَن أمامي من هول رؤية امرأة عجوز بلا أسنان! ثبته جيدًا، فتحت فمي وأغلقته أكثر من مرة للتأكد من ثباته، أحكمت ربط الإيشارب الصغير فوق ما تبقى من شعري الأبيض القصير، وضعت نظارتي فوق عينَي ثم أنزلت قدمَي على الأرض، وبدأت التحرك ناحية الباب.
جرس الباب في العادة يأتيني بقلة صبر من يقف وراءه، أما هذه المرة فكان الواقف خلفه صبورًا خلوقًا، يضغط على جرس الباب ليتأكد فقط من أنني أسمعه، يضغط دون أن يستعجلني.
ظننت أنني لن أصل أبدًا، ولكنني وصلت في النهاية، أزلت قفل الباب الذي لن يحميني إذا حاول أحدهم اقتحام شقتي، ولكنه يشعرني بالأمان على أي حال! أنزلت يدي لفتح الباب، وأول ما رأيته أمامي كان نفسي!
رأيت نفسي وأنا في العشرين من عمري أو أقل!
أكره هذا الجسد! جسد يعجز عن الوقوف بثبات، عينان غائمتان لا تساعدهما نظارتهما الطبية على الرؤية الصحيحة، وعقل تشوش من وحدته الطويلة؛ حتى هيأ لي أنني أرى نسختي الشابة!
عقدت حاجبَي وسألت:
– مين؟
جاءني صوت نسختي الشابة ناعمًا هادئًا:
– إزيك يا تيتة؟
– تيتة!
– أيوه يا تيتة! أنا مارية! مارية بنت علياء، علياء بنتك.

٢
أنجبتني أمي ابنة وحيدة بعد أربعة أشقاء ذكور، بفارق عشرة أشهر بين كلٍّ منهم! حتى أتيت أنا.
تقول أمي إنني السبب في وقف سيل الإنجاب الذي لم يرحمها أبي منه منذ أول ليلة في زواجهما! فكلما أنجبت ولدًا، دفعها إلى إنجاب آخر، أربعة ذكور رفعوا رأس أبي إلى السماء، ثم جئت أنا لأكسر خاطره وأضع رأسه في التراب. يومها غضب أبي وود لو يتخلص مني لولا أنه صاحب قلب منعه من فعلها، فأقسم على أمي بدلًا من ذلك ألا تنجب ثانية، فنجوت.
تحبني أمي لأنني رحمت جسدها من غزو أبي له مرارًا وتكرارًا، فقد عزف أبي عن جسد أمي عدة سنوات غضبًا وعقابًا! عدة
سنوات بقيت فيها معها في غرفتها، أنا وهي فقط، ثم قرر أبي في ليلة العودة إليها أن يتوقف عن عقابها، ويبدأ في عقابي أنا!
فنزعني من جوارها ووضعني في الغرفة الأخرى التي تضم إخوتي، واستقر هو في الجوار ذاته! عاد إليها وعاد لغزو جسدها، لتسعى إلى إجهاض جنينين نتيجة ذلك الغزو المتكرر، دون أن يعلم أبي وبمساعدة وصفات بعض النسوة، ثم انتشرت بعدها وسائل منع الحمل ووصلت إلى محيطها لتنجو أمي من الإنجاب ومن غضب أبي.
أما أبي فيكرهني لأنني فرقت بينه وبين زوجته عدة سنوات، ولأنني أنا.
مثلت أمي لي درع حماية من غضب أبي، ولكنها تغافلت عن تجاوزات إخوتي معي! تحميني طوال النهار من أبي وتعنيفه، وتتركني ليلًا في غرفة صغيرة مع أربعة إخوة أكبر مني!
يأتي الصباح، أذهب إليها بعد خروج أبي إلى عمله، بعقل طفلة مشوش ولسان لا يملك مفرداته فيعجز عن الشرح، لا تنظر إلى وجهي، لا تتكلم، فقط تصنع طعامًا وتمنحني إياه خلسة، تدخلني غرفتها، تحديدًا شرفة غرفتها التي تبدو كالعلبة، أجلس أرضًا بطبق الطعام أراقب السحب المتحركة فوقي.
عندما ماتت أمي، فقدت درع حمايتي، زوجني أبي مباشرة، أنجبت في البداية ابنتي؛ علياء.
لم أنجب غيرها ولم أحاول، فقط حمدت الله أنها هي، هي فقط ولا إخوة معها. وظننت أنني بتركها دون إخوة قد قدمت لها ما هو مطلوب مني بالفعل، لقد قدمت لها الحماية في بيت نشأتها، وجدت هذا كافيًا ولم أسعَ إلى فعل شيء آخر!
لتصبح الأم أمًّا؛ يجب أن تكتسب احترام أبنائها. وأنا لم أكتسب احترام ابنتي الوحيدة يومًا! ربما أحبتني لأنني أمها، أشفقت عليَّ
حينًا وكرهتني أحيانًا أخرى، ولكنها لم تحترمني قَطُّ.
آخر مرة تلاقت فيها أعيننا، أخبرتني عيناها أنها راحلة، لن تبقى معي ثانية، لا تطيق حياتها مع امرأة مثلي.
غضضت الطرف عن كل حقيبة تظن أنها تخرجها خلسة من البيت، عرفت أنها تختفي يومًا بعد يوم، غرفتها تتعرى من وجودها
وسيطرتها. رأيت وعلمت واخترت ألا أفعل شيئًا. حتى لحظة خروجها النهائي؛ شغلت نفسي في المطبخ بصنع شيء لا أذكره،
وتركتها تخرج دون نظرة وداع أخيرة! الغريب، أن فور خروجها وسماع صوت غلق الباب خلفها، شعرت بالراحة!
وقع سماع اسمها الآن بعد كل تلك السنوات من فتاة تحمل ملامحي وتقول إنها ابنتها؛ أمر غريب! دققت النظر مرة أخرى،
رددت بصوت هامس:
– علياء!
كأنني أنطق الاسم لأول مرة! بل وكأنني أسمعه لأول مرة، وكأنني لست الأم التي اختارت هذا الاسم لابنتها من الأساس!
نحيت نفسي جانبًا قبل أن تفقد الفتاة أعصابها ويقتلها الخجل والتردد، وقبل أن تنفذ رغبتها في الهرب التي أعلم أنها تشعر بها
الآن! نحيت نفسي وأشرت:
– اتفضلي يا بنتي! ادخلي.
تحركت أمامها وتركت لها مهمة غلق الباب خلفها. سرت نحو غرفة الأنتريه، الغرفة الثانية صاحبة النافذة العالية الرفيعة التي تطل على فاصل رفيع بين مبناي والمبنى المجاور، فاصل يسمح بمرور خيط حاد من الضوء يكفي لإنارة الغرفة نهارًا، نافذة عالية رفيعة محاطة بسلك ضيق يمنع دخول كل شيء عدا التراب. التراب الذي غلف خشب الأنتريه والأرضية وأضاع لون السجاد. تحت النافذة تقبع الأريكة الرئيسية التي تحمل كسوتها قطعًا كبيرًا يكشف تنجيدها البالي، جلست على كرسي بجوارها ووضعت يدي على القطع وأنا أشير لها بالجلوس، داعية الله ألا ترى شيئًا آخر في الغرفة! جلستْ في حماس وكأنها لم ترَ شيئًا بالفعل! لم تتوقف ولم تحرك عينيها في الغرفة، فقط نظرت إليَّ وأنا أوازن جلستي على الكرسي بجوارها في بطء وألم، انتظرت قليلًا لأمنحها فرصة تولي دفة الحديث، ولكنها اكتفت بالنظر إليَّ والتمعن في ملامحي!
– إزيك يا تيتة؟
كررتها مرة أخرى!
– الحمد لله يا بنتي!
أكملتْ بنفس الحماس الذي لم تتخلَّ عنه:
– أنا كنت عايزة أجيلك من زمان، ماما ما كانتش معرفاني السكة! بس أنا عرفت أوصلك في الآخر، سألت لحد ما وصلت، واستغربت أوي من الناس اللي كل ما أسأل حد فيهم على البيت، يتخضوا ويبصولي بطريقة غريبة! ليه كده يا تيتة؟ وليه
كانوا بيوصفوا البيت بـ«بيت الحريم»؟!
قاطعت حماسها وسيل أسئلتها:
– تشربي إيه؟
– لأ شكرًا يا تيتة، مش عايزة حاجة.
ثم ابتلعت جزءًا من حماسها وأظهرت جزءًا من ترددها وارتباكها وأكملت:
– أنا كنت جاية أعزمك على فرحي.
– فرحك!
– أيوه! أنا هاتجوز الشهر الجاي وكنت عايزاكي تكوني موجودة.
– تتجوزي إيه يا بنتي! إنتي لسه صغيرة أوي على الجواز!
ضحكتْ بارتباك وهزت كتفيها:
– يا ريت تقولي لماما كده! هي مصممة! شكلها عايزة تخلص مني.
ثم ذهب حماسها وترددها وارتباكها وحل قلقها.
– هتيجي يا تيتة؟
– آجى فين؟ فرحك!
– أيوه!
– يا بنتي، أنا أول مرة في حياتي أشوفك النهارده، وأمك آخر مرة شفتها يمكن كانت قدك كده! فرح إيه اللي عايزاني أحضره! أنا ما حضرتش جواز أمك ذات نفسها!
– ماما وبابا اتطلقوا من زمان! من وأنا صغيرة.
– وعايزة تتجوزي بدري كده! مفيش اتعاظ خالص!
امتلأت عيناها بالدموع فجأة.
– أنا مش عايزة أبقى لوحدي يا تيتة!
هذه الفتاة تبدو وكأنها جاءت لتجلس أمام كاهن اعتراف! تفرغ ما حفظته من كلمات في أقل مساحة ممكنة! جاءتني مشحونة، مشحونة بالمشاعر! باليأس والوحدة! وبأشياء أخرى أجهلها!
سألتها ثانية:
– تشربي إيه؟
هزت رأسها بالنفي، ثم تركت نفسها للنحيب، ربت على ركبتها بيدي واستندت عليها في نفس الوقت لأتحرك ناحية المطبخ لأحضر لها شيئًا تشربه، حاولت طوال الطريق أن أتذكر ما في مطبخي ويمكن تقديمه لها!
إنه التراب الذي يكسو كل شيء!
فتحت الثلاجة، فاضلت بين صنع عصير جوافة من بقايا حبات موجودة، أو صب بعض العصير من علبة معبأة! ذهبت مع الاختيار الثاني؛ أو عدم قدرتي على الوقوف طويلًا هي ما قررت. أخرجت كأسًا صغيرة من إحدى الخزائن وأخرجت من الثلاجة علبة العصير التي كنت قد ابتعتها في أول الأسبوع، أو الأسبوع الذي يسبقه! لا أذكر؛ ولكنني أذكر أنه لم يعجبني طعمه وتركته!
ملأت الكأس الصغيرة ودعوت الله أن ترفض تناولها، ثم وضعت الكأس في طبق وعدت إليها.
في لحظة عودتي شهدت توقفها عن البكاء، وضعت العصير أمامها، مدت يدها وقبضت على الكأس ثم بدأت شرب العصير!
أنهت نصف الكأس في رشفة واحدة، وقبل حتى أن أعود أنا إلى جلستي بجوارها!
شكرتني وأكدت أنها في حاجة بالفعل إلى شرب عصير برتقال طازج! إنه عصير برتقال إذن! لهذا لم يعجبني؛ فأنا لا أحب عصير البرتقال.
صمت، وتركتها تستكمل شرب العصير، الذي أكاد أجزم أن صلاحيته انتهت.
أعادت الكأس، ونظرت إليَّ بابتسامة معتذرة.
– أنا آسفة يا تيتة!
– على إيه؟
– على الطريقة اللي بدأت بيها الكلام معاكي.
هذه الفتاة تحمل أكثر من مجرد طلب حضور حفل زواجها، وأنا أكره طرح الأسئلة، وهي تسعى إلى إقامة حوار طويل لا أعلم كيف أبدأه، ولا ماذا أقول فيه! لقد استيقظت بسؤال واحد: لماذا أبقى حية حتى هذا اليوم؟ والآن يموج عقلي بأسئلة لا أدري كيف أسيطر عليها!
زاغت عيناها قليلًا عندما لم تجد ردًّا مني، فركت كفيها وكأنها تبحث عن طريقة تواصل أخرى، وأنا لا أدري ماذا أفعل لأسقط
الحواجز بيننا، وننتقل مباشرة لما تريد قوله أو سبب مجيئها الحقيقي!
ثم تذكرت شيئًا.
– علياء زمان ما كانتش بترضى تحكيلي حاجة عنها إلا لما أقول حاجة عني، كانت بتساومني؛ تقولي احكيلي سر عنك عشان
أقدر أحكيلك سر عني، ما كانتش بتآمن تحكي أسرارها من غير ما تاخد ضمان للي بتحكيه! حتى لو كان من أمها!
هزت رأسها تأكيدًا لما أقول وكأنها جربت نفس الطريقة مع علياء؛ أمها! ثم واصلت فرك يديها. عرضت عليها:
– تحبي أقولك سر عني؟
رفعت رأسها وسألت دون تفكير:
– ماما قاطعتك السنين دي كلها ليه يا تيتة؟
– دي حكاية طويلة يا بنتي! خلاصتها إن مامتك عندها حق، بُعدها عني كان أحسن قرار أخدته.
عادت إلى فرك يديها ثم تناولت كأس العصير وشربت نصفها المتبقي على رشفة واحدة أيضًا! ثم نظرت إليَّ وأكدت:
– إيه السر اللي هتقوليه طيب؟!
آه يا بنت علياء! تمامًا كأمك! لا تستسلم أبدًا، لا تمل ولا تترك أمرًا بدأته حتى تنهيه، لا ترحل قبل الحصول على الإجابات، ولا
تصمت إلا وقد قيل كل الكلام.
الفرق بينك وبينها أنكِ تسألين بحسن نية، أما علياء، فكانت تسأل لتصيد الأخطاء في الإجابات. تسألين بغرض المعرفة، وتسأل هي بغرض إثبات وجهة نظرها، إثبات صحة ما تعتقد وما تتمسك به.
تسألين بنظرة بريئة تستجدين بها الحديث، وتسأل هي بنظرة لوم وبغض لم أنسَها حتى هذه اللحظة؛ على الرغم من أن ذاكرتي تتلاعب بي يوميًّا! ذاكرتي التي لا تتعب ولا تمل من تكرار عرض صور حياتي أمام عينَي! ما عشته، ما اقترفته! ما سُلب مني، وما جادت به الحياة في غفلة من الزمن!
عندما تكبر في السن، تضيق حياتك وتتقلص نشاطاتك، تتوقف عن فعل أشياء جديدة، فيظل القديم ماثلًا أمام عينيك، يلومك، يذكرك بمكان زلاتك وأوقات انتكاساتك، تتضاءل إنجازاتك أمام العمر الطويل، فالحياة سيئة، وكلما تقدم بك العمر، ظهر السوء جليًّا ليفسد ما تبقى لك فيها!
أعادتني عينا حفيدتي التائهتان إلى جلستي، شعرت بأنها ربما تكون فرصتي قد جاءتني لتفريغ تلك الذكريات التي يزدحم بها
عقلي وتطاردني إلى الآن.
تنهدت وسألتها رغبة في سرد أي سر يريحها، وربما يريحني أنا أيضًا سرده وإخراجه من داخل رأسي:
– عايزة تعرفي الناس كانت بتتخض ليه لما بتسأليهم على البيت هنا؟
نظرت إليَّ بشيء من التعجب! وكادت تنطق: أهذا سركِ! لكنها هزت كتفيها بإحباط:
– اللي تشوفيه يا تيتة!
٣
وضعت أمامها علبة عصير البرتقال لعلها تلاحظ تاريخ الصلاحية الذي أعجز عن رؤيته، والذي حتمًا سيشير إلى انتهاء صلاحية هذا العصير، لكنها بدلًا من ذلك، ملأت كأسها الصغيرة مرة أخرى وبدأت الشرب بسرعة ثانية!
نظرت إليها وأنا أكاد أجزم أنني أرى نفسي، أرى تلك الفتاة التي تقبل بكل شيء مهما كان: الجلوس في بيت يكسوه التراب دون
تململ أو شعور بالاشمئزاز، تناول عصير منتهي الصلاحية، الجلوس فوق كسوة أنتريه ممزقة دون امتعاض، النظر إلى امرأة عجوز تتكلم بمخارج ألفاظ غير واضحة بسبب طقم أسنانها.
تذكرني بي؛ بالطفلة التي كانت تنسى بؤس لياليها بطبق طعام من أمها والجلوس في أرضية شرفة كالعلبة تنظر منها إلى السماء،
بالشابة الصغيرة التي ارتضت الزواج من أول رجل تقدم لخطبتها، أول رجل طرق باب أبيها وطلبها منه، فأمسك أبوها بيده متشبثًا به وكأنه سيخلصه من مصيبة تقبع في بيته! ارتضت أن تتزوج في شقة أرضي لا شرفة فيها، ارتضت أن تعيش دون رفاهية كان يستطيع زوجها منحها إياها، لكنه رأى أنها لا تستحق، ارتضت أن تحتقرها ابنتها وتوجه لها الإهانات كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا!
ارتضت أن يُقال عنها عاهرة في شبابها ونضوجها، ارتضت وظلت مكانها على الرغم من أنها تستطيع الخروج من كل هذا لو أرادت!
نظرت إليها وتساءلت: لماذا لم ترث من أمها الشعور بالاستحقاق؟ لماذا لا تسير بين الناس وتشعر بأنها تستحق الأفضل؟ لماذا لم ترث من أمها النفور مني؟!
انتظرت أن تنهي كأس العصير الثانية ثم تصرخ متألمة من معدتها، لكنها أنهتها ونظرت إليَّ بابتسامة مشجعة.
– ها يا تيتة! احكيلي بقى! ليه الناس كانت بتتخض لما أسألهم عن البيت هنا؟
– عشان فيه عفاريت.
قلتها وضحكت حتى تراقص طقم الأسنان داخل فمي. لم تبادلني الضحك وبدأت التلفت حولها! أكدت لطمأنتها:
– ما تخافيش يا بنتي، مفيش عفاريت هنا غيري.
لم تضحك هذه المرة أيضًا، وابتسمت ابتسامة مرتجفة!
سألتها بوجه جاد مشفق عليها:
– فاضية تسمعي الحكاية؟ دي حكاية طويلة!
– احكي يا تيتة، احكي.
قالتها وقد عاد حماسها الأول!
قررت أن ألجأ إلى حيلتي الأخيرة للتخلص من فكرة الحكي.
فكرة الحكي التي ستعيد إحياء ما عشته وما صحبه من آلام. فكرة الحكي التي تجرني إليها حفيدتي خوفًا من التصريح المباشر عن سبب مجيئها، والتي تدفعني إليها رغبتي في التخلص من ثقل الذكريات.
أدخلت أصابعي في فمي وأخرجت طقم الأسنان، ووضعته بجوار كأس العصير الفارغة.
– معلش، لو هاحكي، هاحكي من غيره عشان بيبوظ كلامي!
انتظرت نظرة الاشمئزاز! ولكنها بدلًا من ذلك، ابتسمتْ في خجل.
– والله يا تيتة كان نفسي أقولك كده من ساعة ما قعدت! خليكي براحتك.
يا الله! ممَّ صُنعت هذه الفتاة؟ حتى أنا كنت سأجفل قليلًا!
وجدت في النهاية أن لا مفر؛ فبدأت الحكي.