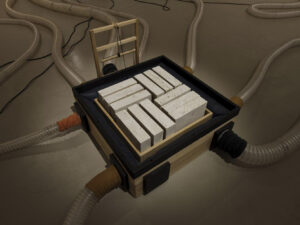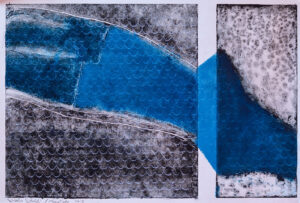بعد عشرين سنة في السجن، يخرج مسجون سياسي ليكتشف أن العالم قد تغير تمامًا، كل الأحلام تحققت، كل شيء يبدو مكتملًا، لكن هل هو كذلك بالفعل؟ قصة قصيرة مميزة لمروان عبد السلام.
مروان عبد السلام
أمسك الضابط كتفي ودفعني إلى الداخل. حاولت أن أتملص من بين يديه، ولكن ما كانت مقاومتي سوي وقودًا أشعل غضبه أكثر وأكثر، سحبني بنفس القسوة إلى غرفة بدت معتمة في البداية، حتى اكتشفت بعد ذلك أن هناك مصدرًا وحيدًا للضوء، يقبع عند ركن الباب السفلي. عمود ضئيل من النور صار بمثابة صديقي الوحيد ومرمى بصري داخل ذلك السجن المعتم.
لقد كنا خمسة… خمسة شباب، كنا ثوارًا على ما أعتقد. كانت قضيتنا الأساسية هي الحرية، أن نحيا بسلام. كنا ضد الحروب، ضد العنف، ضد القيود، ضد السلطة، ضد الفساد… تقريبًا كنا ضد كل شيء. كنا جماعة صغيرة، منبثقة من كيان أكبر. كانت أحلامنا أكبر من أعمارنا، ولكن حظنا العاثر وضع حدًا سريعًا لكل ذلك.
تم إلقاء القبض علينا في أحد المظاهرات السلمية التي خرجت باسم حقوق المواطن، ومن هنا بدأ الجحيم. ذقنا الويل في الطريق إلى هذا المكان. ومنذ أن أدخلوني إلى تلك الغرفة وأنا لا أعرف شيئًا عن الباقيين، لا وجوه، لا أصوات، ولا حتى ظلال. وجدت نفسي معزولًا عن كل شيء. فرقونا بلا تفسير.
حاولت أن أنادي، أن أصرخ، لعل أحدهم يستجيب لي أو حتى يسمعني، ولكن لا مجيب. لا شيء يصلني سوى طبق طعام يُلقى إليَّ في منتصف كل يوم. يوضع على الأرض ثم يُغلق الباب من جديد، ولا شيء غير ذلك. كنت شبحًا، لا يُنتظر منه صوت ولا حركة.
مر أسبوع كامل على هذا الحال، بلا أي تغيير. الأيام تتكرر كما هي، بنفس تفاصيلها الباهتة، حتى جاء ذلك اليوم.
صوت ارتطام عنيف، خبط هستيري يهز الجدران، أصوات بعيدة تتقاطع خارج الغرفة، تمنيت لو كنت بالخارج، فأفهم ما يحدث، لكن القدر ساعدني حينها، واختصر عليّ المشهد.
فُتح الباب، خلفه كان أربعة رجال، يتقدمهم رجل أقصر قامة قليلًا. تأكدت حينها من ملامحه أنه هو الضابط هنا.
حاولت أن أخرج منه بكلمة واحدة، تفسير، أي شيء يعيد لي وعيي، ولكنه لم ينطق. واكتفى بالإشارة إلى العسكري الآخر الذي تقدم نحوي بخطى بطيئة. ثم فجأة، وبدون أي مقدمات، نزلت الصفعة على وجهي كأنها جبل سقط من السماء. حاولت أن أقاوم، أن أركل أو حتى أتحرك، لكن جسدي أبى أن يتحرك. لم يعد يستجيب لي.
شعرت بأطرافي تخونني حينها، وبدأت أعضائي تنهار واحدًا تلو الآخر، حتى وجدت نفسي مشلولًا تمامًا، أعمى، بلا حراك. لم أعد أرى شيئًا، لكنني كنت أسمع بوضوح. سمعت صوت الأمين وهو يقول بهدوء مرعب:
– خذوه إلى أقرب مستشفى… ثم اتركوه يعبث بعيدًا.
حملني الرجال الأربعة بعدها على محفة، حتى وصلت سيارة الإسعاف لتقلني. بعد لحظات قليلة انصرف الجميع، وبقي واحد فقط إلى جواري يراقبني حتى النهاية. كنت مشلولًا، لكن رأسي يعجّ بالأفكار. كنت أفكر في الجملة الأخيرة التي ألقاها الضابط إليَّ بلا اكتراث، ألقاها ثم ذهب. حاولت أن أطرد صدى تلك الكلمات من رأسي، أن أتمسك بشيء من الكرامة. لكن إحساسي بالعجز والمهانة كان مسيطرًا. للحظة ما، شعرت أنني كنت بالفعل مجرد كلب يعبث في الطرقات، لا أكثر.
دخلت المستشفى، وكانت الأنظار كلها متجهة نحوي. لم أرها، ولكنني سمعتها. سمعت كلمة تُلقى من بعيد. كان الرجل يقول أنني استحققت ذلك. ورد عليه الآخر أنني ما زلت طفلًا. لم يكن التصريح الثاني أهون علي من الأول. ظللنا نتحرك قليلًا في الطرقات حتى بدأ سمعى يخذنلي هو الآخر. وفي لحظة ما كنت قد فقدت كل حواسي، انعزلت عن العالم. وأصبحت تمامًا مثل السرير الذي أرقد عليه. لا أشعر، لا أعبر، ولا حتى أفكر في ما يجري؛ كنت قد فقدت وعيي بالكامل وأصبحت مجرد جثة هامدة لا تقدر حتى على العبث في الشوارع مثل الكلاب.
ظللت على هذه الحال لا أشعر بشيء، ولا أدري حتى بمرور الوقت. ربما بقيت شهرًا، ربما سنة، ربما سنتين، ربما عشر سنوات. لا أعلم. كل ما أدريه… وأدريه تمامًا، أنني حين أخرج من هنا، سأخرج ككلب مسعور. سأشيط في العالم، سأثور، سأقلب العالم.
ربما كنت اسمِّي نفسي ثائرًا حين كنت في الخارج. لكن لا… الآن فقط أصبحت ثائرًا ثائرًا حقيقيًا. مشلول، ولكن ثائر. ثائرًا أكثر من أي وقت مضى. وبالتأكيد حين أخرج من هنا لن أكون مجرد رجل مكسور. بل سأكون قنبلة، سأكون مشكلة في وجه العالم… سأدمِّر العالم.
ها أنا ذا مجددًا، لا أعلم كم من الوقت قد مر على بقائي، ولكن ما أعلمه علم اليقين، هو أن الوقت قد حان لقيامي. وإن كنت أنوي الثورة على هذا العالم بأكمله، فربما أجدر بي أولًا أن أثور على نفسي، أن أسيطر عليها، أن أضعها تحت قدمي. وأول شيء سأفعله الآن، هو أن أشرب كأسًا من الماء. وربما يكون مجرد التفكير في شرب الماء يبدو بسيطًا، لكنه بالنسبة لي ليس سوي إعلان مبكر عن استعادتي للإرادة. تحكم جزئي، نعم… ولكنه لا يكفي.
لتنهضي أيتها القدم… انهضي واخدمي سيدك العزيز. لتقومي أيتها اليد… تحركي في خدمته. انهض أيها الجسد. أنتم الآن تحت سيطرتي. سأغلبك أيها الجسد، ستكون أنت عبدي من الآن، فلتخنع أمامي.
أفقتُ أخيرًا، وشربت كأسين من الماء. كانا بمثابة نبيذ النصر بالنسبة إليَّ، النصر الصغير على ذلك الجسد المتمرِّد. والذي كنت متأكدًا أنه سيكون نصرًا على العالم أجمع يومًا ما.
تحركت ببطء داخل طرقات المستشفى، عاريًا تمامًا، منتظرًا من الأمن أن يوقفني، أن يُلقي القبض عليَّ، أن يُعيدني إلى حيث كنت، ولكن ذلك لم يحدث. ظللت أمشي بخطوات مرتجفة ولكنها حرة، حتى خرجت من المستشفى تمامًا.
خرجت إلى الشوارع، مشيت عاريًا أيضًا، ولكن لم يحدث شيء. شعرت بشيء غريب. كان الصمت ثقيلاً.
اقتربت من الطريق العام، لا شيء. الهدوء التام والسكينة المتكلسة يسيطران على المكان. كنت أبحث عن الضوضاء، عن الفوضى، عن الحياة كما عرفتها. أين السيارات؟ أين صوت المزامير الذي يفقع الآذان؟ أين الحوادث التي تملأ الطرقات؟ أين الرجال المتشاجرون؟ أين اللصوص؟ أين الشحاذون؟ أين الضباط؟ أين ذهبوا جميعًا؟ أين ذهب الناس… أمثالي؟
الحياة هنا تسير بإيقاع ثابت، لا خلل فيه. لم أجد شيئًا خارجًا عن المألوف، بل إن “المألوف” نفسه بدا جديدًا عليًّ، غريبًا، ميتًا. لا أحد يصطدم بي. لا امرأة تتعرض للتحرش. لا نظرات، لا ملامح حادة، لا انفعالات. الجميع هنا يتحركون في هدوء، كانوا كالآلات. وها أنا ذا… أراهم.
قررت حينها أن أذهب إلى صديقي القديم، ذاك الذي كان معي وقت القاء القبض عليَّ، لعلي أجد عنده الحل، أو ربما عزاءً من نوع ما.
وقفت أمام منزله وكان هادئًا هو الآخر. في العادة تكون تلك المنازل القديمة عاجة دائمًا بالصراخ والركض. أصوات الأطفال والحركة، ولكن لا. لم أجد ذلك. كان كل شيء ساكنا.
ضغت الجرس أكثر من مرة، حتى جاءني الصوت من بعيد، باهتًا ورتيبًا:
– من هناك؟
فأجبت بصوت ينبض بالقوة، لا أدري من أين خرج:
– هل يوجد أحد هنا؟
فردّ المتحدث بخنوع تام، وبنغمة ساكنة تشبه كل شيء حولي:
– ها أنا ذا… قادم.
ثم فُتح الباب، وكان هو، هو الذي فتح.
حيَّاني ذلك الصديق القديم حينها بحرارة. وعانقني بشوق، ثم دعاني إلى الدخول. فدخلنا إلى المنزل، وكان الجو قاتمًا. طلبت منه حينها شيئًا لأرتديه، فأعطاني سروالًا رماديًا وقميصًا أسود باهت.
جلسنا نتحدث. امتد حديثنا لما يقارب الثلاث ساعات، بلا انقطاع، بلا ملل. كنت أحاول تعويض كل ما فاتني على مدار كل تلك السنين دفعة واحدة.
وفي تلك الساعات القليلة اكتشفت أنني كنت نائمًا لمدة عشرين سنة. أما هو ومن معه، فلبثوا في ذلك السجن ثلاث سنوات إضافية، ثم خرجوا واحدًا تلو الآخر.
أخبرني بأن المجموعة قد تفككت، وأن كل واحد منهم قد شق طريقه الخاص. ثم بدأ يسرد عليَّ ما جرى في هذا العالم الغريب من تحولات.
في البداية حدثني عن عدد من السلاسل المتتالية من معاهدات السلام التي عقدت بين الدول وبعضها، وعن حالة السلم التي دخلت بين كل الكيانات المتنازعة، فتوقفت الحروب، واختفت النزاعات. حتى المشاكل الداخلية الصغيرة قد انتهت. أصبح السلام هو المهيمن الوحيد على هذا العالم. لا طغاة، لا أنظمة فاسدة، لا ديكتاتوريات. كل شيء قد انتهى.
ثم أخبرني أن كل ما كنا نثور لأجله في الماضي قد تبخر، صار هباءً لا معنى له. انفكّت كل الجماعات في أنحاء العالم المختلفة، وصاروا ككتلة واحدة. كل الأصوات قد خفتت.
ثم صرح لي بعدها أن الشرّ قد اختفى تمامًا من العالم. وكأن إلهًا ما قد حن على تلك الكوكبة من البشر المتنازعين، وألقى عليها جزءًا من روحه، ثم محي منها كل الشر. ومع اختفاء الشر سقطت تباعًا كل ملحقاته. الفقر والكراهية، العداوات والصراعات، حتى العلاقات بين البشر أصبحت باردة. الناس يعيشون في عزلة ناعمة، كل شخص في حاله. حتى إذا ما رأو شخصًا ما عاريًا تمامًا في الشارع، فلن يعبأوا بذلك. لقد أصبحوا كالآلات… مجرد آلات.
كنت أراقبه طول الوقت وهو يتحدث. شعرت أنني كنت أستمع إلى شخص ميت، شخص تمَّت برمجته. رجل مسالم وصامت أكثر من المعتاد. فشعرت بالنفور منه.
ثم سألته عن البقية، أين ذهبوا؟ وكيف أحوالهم؟
فقال إن الجميع قد انساقوا إلى نفس ذات الدائرة، وقعوا في شرك السلام، لم يبقَ أحد على حاله. ولكنه أخبرني أن صديقًا واحد فقط قد كان في غيبوبة هو الآخر… مثلي تمامًا. ولم يستيقظ ذلك الشخص من غيبوبته إلا قبل ثلاثة أشهر فقط من الآن.
وما إن سمعت ذلك، حتى هببت واقفًا. قررت أني سأذهب إليه، لعله هو الوحيد الذي يشبهني هنا، الوحيد الذي لم تتلوث دماغه بعد بتلك السكينة المصطنعة، الوحيد الذي ربما ما زال يحتفظ بشيء من الإنسانية القديمة.
سأذهب إليه فورًا، لعله يفهمني.
خرجت من عند ذلك الصديق قاصدًا منزل الصديق الآخر. حاولت في البداية أن أصفي عقلي من كل هذا، لكن حديثه بدأ يتردد في عقلي أكثر وأكثر.
كنت حائرًا، مشتتًا. ها قد صار العالم كما كنا نحلم، كما تمنينا. لا حروب، لا كراهية، لا فقر، لا ألم، لا طغيان. مجرد عالم نقي. فلماذا إذًا أشعر بالضيق؟ أليس هذا ما كنا نندد من أجله؟ ألم يكن من المفترض أن أكون سعيدًا الآن؟
ولكن لماذا أنا فقط من يشعر بالاستياء الآن؟
ظللت أتمعَّن في وجوه الناس من حولي، علِّي أجد فيهم شيئًا من تلك السعادة التي غابت عني. أردت أن أكتشف أنني أنا الشاذ هنا، وأنهم هم السعداء. قابلت وجوها باهتة، ملساء مسطحة، خالية من أي أثر للحياة. لا حزن فيها ولا فرح. وجوه لا تحمل الذاكرة، ولا حتى الرغبة.
حتى الحيوانات لم تسلم من ذلك الشرك الواهن. حاولت أن أقترب من كلب في الطريق على أمل أن يعضني أو أن ينبح. أن يهرول ورائي، أي رد فعل حقيقي يدل على الحياة. ولكنه اكتفى فقط بالنظر إليَّ، نظرة مفرغة من الحياة. ثم أعاد رأسه إلى الأرض بهدوء بارد.
ظللت أمشي وأنا شارد. أمر من بين السيارات الصامتة، وأعبر من تحت المباني الميتة. وكان أقصي أمل لي وأنا أمشي هكذا هو أن أجد شحاذًا ما يمشي هكذا مثلي، فأضمه، أصادقه، أشحذ معه. ولكن لا… يبدو أنه قد أخذ الشحاذين معه، ذلك الإله المتمرد. ومن ثم ترك شحاذين من نوع آخر. شحاذو المشاعر.
كنت شاردًا تمامًا، حتى أوصلني ذلك الشرود البائس إلى سؤال أعمق وأهم بكثير من أي سؤال آخر: ألا يعد وجود الشر في هذا العالم شرًا بحد ذاته؟
ظللت أتساءل، أليس الشر في حد ذاته يعد مصباحًا لرؤية الخير والإحساس به؟ أليس اختفاء الشر يصيبنا بعمى عن القيم، فلا نعرف معنى للطيبة، ولا جمال للرحمة، ولا حرارة للحب؟ وإن كنا نحن لا نعرف معني الرحمة، سوى بتذوق القسوة. فإن غابت القسوة نهائيًا من الوجود، فإن من الطبيعي جدًا أن تغيب الرحمة. وإن لم نختبر نحن الخسارة بأنفسنا، فلن نعي أبدًا معنى للفوز.
أليس عالم بلا شر هو ذاته عالم بلا خير. تمامًا كما أن الظل لا وجود له بلا نور. ومع اختفاء كل تلك الأمور فلن يبقي لنا في النهاية سوى مجموعة من الدمى المتحركة، تأكل وتنام وتتحرك، ولكنها لا تشعر، وبالطبع فهي كذلك لا تعيش. مجرد بشر خالون من بشريتهم.
دفعني ذلك التفكير المطول إلى رفع رأسي نحو السماء، ومواجهة ذلك الإله بنفسي. حملت عيني كل الأسئلة، كل الحيرة، بل وربما شيء من العتاب. كنت أريد محاسبته، محاكمته، أو مجرد فقط التحدث إليه وجهًا إلي وجه.
ولكنني حالما أعدت رأسي إلى الأرض مجددًا، متذكرًا من أكون. أنا لا شيء. مجرّد بشري واهن، لا يفقه شيئًا أبدًا. في مواجهة ذلك الإله المعظم. كلي الحكمة، وكلي القوة. الموجد لكل شيء، وهو النازع أيضًا لكل شيء. تذكرت حينها مدى وهني، ومشيت في طريقي.
***
وصلت أخيرًا إلى منزل ذلك الصديق الآخر، وكلي شوق إلى لقائه.
ضغطت الجرس أكثر من مرة، انتظر الرد، ولكنه لم يأتِ. انتظرت طولًا بلا حركة. ضغطت الجرس مجددًا حتى جائني صوت من بعيد بدا لي كأنه صوت امرأة.
سألتها بصوت خافت أقرب للرجاء:
– أهناك أحد هنا؟
فجائني الرد سريعا:
– لقد ذهب إلى القهوة.
شكرتها ثم تحركت.
كنت في البداية أنوي اللحاق به، ولكن شيئا ما بداخلي بدأ يخبو، فقدت فجأة الرغبة في لقائه. عدت مجددًا إلى السير في الشوارع، ثم بدأ ذلك الشعور بالتفاقم أكثر وأكثر. بدأت تدريجيًا أفقد الشعور تمامًا.
وما أن وصلت عند ذلك الجسر حتى قد كنت فاقدًا تمامًا للإحساس. لقد تحولت أنا الآخر إلى دمية بائسة. لقد لعنني ذلك الإله، لقد عاقبني. لقد أصبحت في سجن أكبر الآن.
لكنني لن أقبل بهذا. لن أكون أبدًا دمية. سأعارض رغبة الإله، سأواجهك أيها الإله. سأرفض ذلك المصير، ولن أكون أبدًا دمية تحت يديه.
تحركت ناحية الجسر مهرولًا، ثم صعدت فوقه. وفي لحظة مقدسة كتلك اللحظة، أخذت دموعي في الانهمار، تدفقت نحو فمي واستقرت هناك. وكأنها أرادت أن تكون نبيذ نصري الأخير. نبيذ نصري على الإله.
قفزت، كنت كمن ملك الدنيا وما فيها. لقد عارضت الإله… لقد انتصرت على الإله.