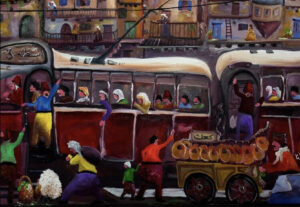في روايته الأولى، يكتب عبد الله ناصر عن عائلة تظهر جانبًا غامضًا من حياة أحد أفرادها، الأب الودود ذو الهيبة، وأيضًا المشهور بارتباطه بقضية جنائية غير معتادة، ومع تلك الشهرة فلا يتكلم عنها أحد مطلقًا.

١
كانت لأبي ثلاثة مسدسات، وبندقية صيد، وترخيص قديم لحمل السلاح.
أما المسدسات ففي الرف العلوي للخزانة، إذ طالما أخفى أبي أشياءه الثمينة هناك. لن يفتش الملابس من يبحث عن المسدسات، لكن قد يعثر عليها من لا يبحث عنها، كما حدث ذات يوم حين أرسلني أبي لإحضار سترته الصوفية. وأما البندقية فإلى جانب باب المجلس القديم، تستند إلى الجدار مثل البندقية التي رسمها رينيه ماغريت في لوحة «الناجي»، غير أن الأرض تحتها تخلو من بقعة الدم. وأما ترخيص السلاح ففي أحد الأدراج المليئة بالأوراق وأرقام الهواتف والفواتير وبطاقات الأعمال وكل ما لم يتخلص منه أبي مخافة أن يحتاج إليه يومًا ما.
كنت قد شاهدته في صباي ينظف مسدساته الثلاثة بعدما فكَّكها في فِناء البيت. وقفتُ على أطراف أصابعي لأتعلق بإفريز النافذة وأتلصص عليه، ولما انتبه إلى الوجه الصغير الملتصق بالزجاج ابتسم ودعاني إليه. كان قد فرغ من تزييتها وتركيبها وراح يمسح عليها برفق. وقبل أن أتخيَّل المسدس في يدي قال: «لا تُدخِل سبابتك أبدًا في قنطرة الزناد». وعدني أن يعلِّمني الرماية بالبندقية عندما يحين الوقت، أما المسدسات فقد كان ذلك درسها الأول والأخير.
يعرف أبي أن السلاح لا يخلو بيدٍ إلا وتنجذب السبابة من تلقاء نفسها إلى الزناد، ويعرف ذلك صانعو الأسلحة حين صمموا قفل الأمان تحسبًا لسبابة طائشة، ويعرفه مالكوها فيضع كلٌّ منهم سلاحه في جراب يبقيه بعيدًا عن عينيه. من يقرأ دليل الأسلحة الإرشادي الصادر عن وزارة الداخلية لاشتراطات الأمان يجد كثيرًا من هذه التعليمات: «لا توجِّه السلاح إلى أي أحد»، «صوِّبه دومًا إلى الاتجاه الآمن»، «لا تحمل السلاح عند شعورك بالتوتر»، «احفظ السلاح في مكان والذخيرة في مكان آخر». لكن ألهذا صُنعت الأسلحة؟
كنت قد رافقت صديقي في العام الماضي إلى معرض الأسلحة، فرأيت كيف تتسابق أيادي الزوَّار الخشنة والناعمة إلى المسدسات التي صُفَّت على الطاولات كما تُصف الهواتف الذكية في المتاجر. لفت نظري أن بعض مسدسات غلوك لا تختلف أسعارها عن أحدث هواتف الآيفون، حتى إن ثمن الرصاص يكاد يعادل ثمن إكسسوارات الهاتف.
في أول شقة استأجرها أبي في حي عبدالله فؤاد بالدمام انطلقت رصاصة من مسدسه إلى جدار الصالة، ثم ارتدَّت فاعتلت بالكاد كتفه لتنغرز في الجدار الخلفي. لم تنم أمي ليلتها من الفزع. حاول أبي طمأنتها فطمس أثر الرصاصة. دفع التلفزيون نحو الجدار فاختفى الشق الأول، وعلَّق على الجدار الآخر صورته الكبيرة فتوارت الرصاصة برأسه مثل فكرة. لم تنسَ أمي قَطُّ تلك الحادثة المشؤومة حتى بعد انتقالهما إلى مسكن آخر. ظلت حتى اليوم تشكو من طنين في الأذن -وإن قال الطبيب إنها سليمة- وظل أبي حتى وفاته يصر على أن المسدس كان بلا ذخيرة حين قام بتنظيفه، وأنه قد فرَّغ بنفسه حجرة الطلقة من الرصاص.
لم أره يحمل مسدسًا في حياتي غير مرَّتين. المرَّة الأولى حين سافرنا برًّا إلى بلاد الشام -مصيف العائلة المفضَّل- على طريق الشمال الدولي الذي يزيد طوله على ألف وخمسمئة كيلومتر. توقف إلى جانب الطريق قبل منفذ الحديثة الحدودي بقليل ودفن المسدس هناك، ثم عاد لأخذه في طريق العودة. ما يزال البعض في المدن النائية تحديدًا يسافر بالسلاح مُخبَّأً تحت المقعد مثل سترة النجاة في الطائرة. يحملونه غالبًا على سبيل الاحتياط، إذ ما عاد أحد يقطع الطريق منذ زمن بعيد.
أما المرَّة الثانية فحين عاد أخي الصغير إلى البيت مُحطَّم الأنف بعدما ضربه خمسة من فتيان الحي. أرسلته أمي لشراء الخبز فاستوقفه أحد المراهقين الذين كانوا يتسكعون هناك. ظن أن الولد الصغير لا يستطيع الرد على الشتائم واللكمات. ولما وجد المراهقون صاحبهم يُصرع من ولد يصغرهم تسابقوا إلى ضربه. جُنَّ أبي من الغضب حين رأى وجه أخي الدامي، فخرج بالمسدس بحثًا عنهم. وحين ذاع الخبر في الحي حمل آباء الفتيان الخمسة أبناءهم على الفور إلى مركز الشرطة. بدا غريبًا للضابط المناوب أن يسلِّم الجناة أنفسهم، ولعله تمنى في سريرته لو أن قضاياه المعلَّقة تحل هكذا نفسها بنفسها. ولما علم أنهم ما جاؤوا إلا لإيواء أبنائهم عنده ريثما يسكت عن أبي الغضب، قال إنه لا يعمل في ملجأ، بل في الشرطة، ثم إنه لا يستطيع أن يحبس الفتيان دونما قضية.
حثَّ آباءهم على أن يرفعوا هم الدعوى على أبي، فنحن لا نعيش في غابة، بل في دولة، وفي الدولة قانون: «إما أن تقدِّموا بلاغًا فنقبض على الأب، وإما أن يقدِّم الأب بلاغًا فنقبض على الفتيان، ثم تنظر المحكمة في الشكوى. ما لم يكن هناك بلاغ فلا وجود لقضية! والصلح خير».
راح أعيان البلد يطرقون بابنا كل يوم حتى تراجع أبي بعد وساطة صديقه المقرب سعود ناجي، واقتُص لأخي فانتهت القصة كما بدأت شجارًا بين الأولاد.

٢
يميِّز الابن بنفسه أصدقاء أبيه المقربين. يدرك ذلك بالنظر إليهم أو إلى وجه أبيه، بل ويأنس إليهم كما يأنسون إليه. كلما نظرتُ إلى سعود ناجي فاضت المودة حتى من عينه الزجاجية. كان صغيرًا حين خرج مع والده في رحلة صيد، أطلق النار على غزال فاصطاده. ركض إليه فوجده يئن، دنا منه فوثب الغزال وثبته الأخيرة وخطف عينه. أخبرني بذلك حين كنت في الثامنة من عمري، ثم أسرَّ إليَّ أن عينه الزجاجية تبصر الأشياء عن بُعد مثل الدربيل، حتى إنه يصوِّب بها حين يطلق الرصاص ويغمض عينه الأخرى.
«ألا تصدقني؟»، أغمض عينه السليمة وراح يصف بالزجاجية مجلس أبي، ويشير بيده إلى الباب والنوافذ والستائر والأنوار، ويقرأ الآية المعلَّقة على الجدار.
ولما سألت أبي بعدها ضحك وقال: «لقد أغمض عينه الزجاجية لا السليمة». لطالما أُخِذتُ بقصة الغزال، ولا أدري أحدثت حقًّا أم أنه كان يرتجل ساعتها، لكن إذا كان لا بد لأحدنا أن يفقد إحدى عينيه فليكن ذلك لأجل غزال حقيقي أو حتى مُتخيَّل.
كان سعود ناجي يقص عليَّ كثيرًا من القصص حين لا يجد أبي في البيت، حتى إنه يخيِّرني في أغراض القصة: «أتريد أن تسمع قصة صيد، أم فروسية، أم عشق؟»، فأختار الفروسية في كل مرَّة، لكن قصصه كلها في نهاية المطاف ما كانت إلا عن الصيد. كم أحببته حتى تمنيت لو أن لي مثله عينًا زجاجية. زارنا يومًا حاملًا صقره على شماله. مسح على صدره برفق -كما كان يمسح أبي على مسدساته- ثم نزع عنه البرقع الأبيض فرأيت أجمل طائر في حياتي. انكشفت عينا الصقر البراقتان وجاب نظره الأفق فخبط جناحيه الرمليين خبطة خفيفة. كان جفناه الشفافان ينغلقان أفقيًّا مثل الستائر. لقد نشأنا أصلًا على الإعجاب به، إذ كان من أوسمة الطفولة ونياشينها أن يدعوك أحدهم «صقرًا». ليس لعينيه الحادتين «دربيل»، ولا لجناحيه اللذين تكاد سرعتهما تبلغ عند الانقضاض ربع سرعة الصوت «ماسورة»، ولا لمخلبه الخلفي المقوَّس «زناد»، ولا لمنقاره المعقوف «رصاصة»، ليس لأن الصقر بندقية هوائية طبيعية لا بد من تأمينها بالبرقع «قفل الأمان»، ولكن لنفسه الأبيَّة التي لا تقيم على الضيم.
أهدى سعود ناجي بندقية الصيد لأبي. كان سعود صيادًا مثل أكاتيون، وكانت البندقية من طراز ديانا. سُمِّيت كذلك تيمنًا بإلهة الصيد في الميثولوجيا الرومانية، وقد تسببت في مقتل أكاتيون. بندقية هوائية (سكتون) صُنِعت لقتل الطيور الصغيرة كالدخل والقمري، وطرد الصحفيين كما يعتقد مارادونا. كان الأرجنتيني قد ضاق بهم ذرعًا حين ظلوا يطاردونه بكاميراتهم أينما ذهب. غضب وصوَّب السكتون إلى أربعة صحفيين فأصابهم بجروح سطحية، ثم صاح متوعدًا: «إذا ضايقتموني مرَّة أخرى، فسأخرج بالرصاص الحي فتقع مأساة». لا يزن رصاص هذا النوع من البنادق أكثر من نصف غرام، ويُباع في علب دائرية من المعدن تشبه علب الصبغ القديم للحذاء.
كنا نخرج بالبندقية إلى المنتزه المهجور فنصيد الحمام المتمدِّن الذي يقف على أعمدة الإنارة أكثر من وقوفه على الأشجار. سبقت رحلات الصيد دروس رماية منزلية أهملتها أختي الكبيرة، أما أخي فكان أصغر من أن يحمل بندقية. كان يرافقنا ليجلب الطرائد، إذ كان هو الوحيد الذي يستطيع التسلل إلى المنتزه لاويًا جسده عبر القضبان التي تنحني مثل الأقواس فلا يستطيع عبورها غير طفل أو بهلوان. كنا نصيد من دون أن نغادر السيارة، نفتح النافذة بما يكفي لفوهة البندقية أن تخرج، ونطلق الرصاص
على الحمام الغافل فيهوي إلى الأرض عاجزًا عن خبط أجنحته ولو مرَّة أخيرة. لطالما تصورتُ الروح تهوي من الجسد هكذا عندما نموت، وقبل أن ندرك أنها النهاية ترتطم بالأرض.
في أحد الأيام قال أبي: «سنأكل من صيدنا». كانت أول مرَّة نرى فيها الحمام على مائدة البيت. بدا لحمه منفرًا شديد السواد، ولما رأى أبي أيدينا لا تصل إليه مثل رسل إبراهيم تناول لقمة ثم قال: «إن هذا الحمام لا يؤكل، وما لا يؤكل يجب ألا يُقتل». كانت كلماته وداعًا للسلاح أو تمهيدًا لذلك، إذ سيعلم بعدها بمقتل سعود ناجي خطأً في رحلة صيد فلا يقرب أبي بندقيته سنوات طوالًا. لن يقوى حتى على إعادتها إلى حقيبتها الجلدية، وستبقى حيث تركها آخر مرَّة مستندة إلى جدار المجلس مثل بندقية ماغريت. كلما نظر إليها ترحَّم على سعود ناجي وسرح بعيدًا، وإذا كان الترحم على الموتى يجدد عظامهم -كما تمنى راشد الخلاوي في إحدى قصائده- فلا بد أن عظام سعود ناجي ما كانت تبلى إلا وتتجدد في الحال.
لشدَّ ما حزن أبي على رحيله فما عاد يغادر البيت، وإن غادر فسرعان ما يعود. قد يمضي أسبوع لا ينهض فيه من الفراش. لا يأكل ولا يتكلم إلا بمقدار ما يأكل الطيف ويتكلم. عندما خرج وحيدًا إلى الصيد ظننا أن حداده الطويل انتهى، حتى وجدنا البندقية في مكانها. صار يذهب إلى البحر بالصنارة، وقد رافقته يومًا فكان أضجر أيامي. لم نتبادل كلمة واحدة طوال ساعات، فهمت أننا يجب أن ننتظر فانتظرنا حتى الغروب، وانتبهت وقتئذ إلى طول البال الذي لا بد أن يتمتع به كل صياد وطريدة. لا بد أن أولى جولات المطاردة تبدأ قبل الخروج إلى الصيد ما إن يفكِّر الصياد في القتل وتفكِّر الطريدة في النجاة. وإن كنت لا أعتقد أن أبي كان راغبًا في الصيد بقدر رغبته في الجلوس إلى البحر، إذ كانت صنارته لا تصطاد الأسماك بل تطعمها. لا أتذكَّر أنه عاد يومًا من رحلاته البحرية بسمكة واحدة.
٣
بعد مُضي خمس عشرة سنة تململ أبي أو تململت البندقية فحملها وطاف في فِناء البيت. كان قد بلغ وقتئذ من العمر ما يجعل قلقه من الماضي أكبر من قلقه من المستقبل. أشجاه ترجيع الحمام، فشرع يلاحقه بالرصاص فوق سطحنا وسطوح الجيران الذين كانوا يكنون له قليلًا من الخوف -لحادثة المسدس وفتيان الحي ربما- وكثيرًا من المودة، فقد كان بيتنا مجلس الحي حيث يتردد الجيران كل يوم تقريبًا. الباب مفتوح طوال الوقت ليجلب الضيوف كما كان أسلافنا في الماضي البعيد يوقدون النار لجلبهم. ثمة وليمة كل أسبوع للأقارب، والأصدقاء، والغرباء.
كنت سأخاف لو طرق بابي اليوم أحد الجيران ليخبرني أنه سيطلق النار على سطح بيتي، ويعتذر سلفًا عن أي حمامة تسقط هناك! أتذكَّر حينها أنني سألت أبي، وقد صرنا صديقين أخيرًا، عن ذلك الحظر الجوي الذي أقامه فوق شارعنا. قال -وابتسامة هازئة على شفتيه- إن الحمام يسجع أثناء قيلولته فيستيقظ مكدر المزاج ويظل كذلك حتى نهاية اليوم. لم يقل بماذا يُذكِّره شجو الحمام، وهل كان يطلق الرصاص على الحمام أم على الذكرى. لطالما لف الغموض أبي، فلم أعرف مثلًا حتى المرحلة الثانوية أين كان يعمل. أتذكَّر حيرتي في المدرسة كلما سألني المُعلِّم عن مهنة أبي، إذ كنت أرتجل مهنة جديدة في كل سنة دراسية حتى استقر رأيي على أن يكون محاميًا.
لا أعلم ماذا كان جواب أختي، أما أخي الصغير فأخبرهم أن أبي يعمل محققًا، وقد راجت تلك الشائعة في الحي وعززها خيال أحدهم حين أضاف إليها جهاز المباحث العامة. حين ذهبنا لسؤال أبي ضحك وقال إنه رجل أعمال لكن لا يمانع أن نختار له وظيفة أخرى!
في الدُّرج المليء بالأوراق وأرقام الهواتف والفواتير وبطاقات الأعمال ما يؤكد كلامه. ثمة دفاتر لشركة مقاولات باسمه، وشركة نقليات أيضًا. وفي الدُّرج ترخيص قديم لحمل البندقية تظهر فيه صورة غير ملونة لأبي بالغترة البيضاء، إذ طالما كان يميل لها أكثر من الحمراء. طرف الغترة الأيمن ينسدل على صدره، أما طرفها الآخر فمطوي فوق كتفه اليسرى. عيناه الودودتان لا تلفتان الانتباه لأن من ينظر إلى الصورة أول مرَّة تنصرف عيناه إلى الشارب الكث الذي يخفي شفة أبي العليا، ويبدي شبابه المطمئن. كان ذلك الشارب موضة دارجة حينها، وقد ظل أبي وفيًّا له حتى النهاية. التُقِطت الصورة في استوديو الربيع بدمشق في أواخر السبعينيات. ظل أبي يحتفظ بالنيجاتيف فيعيد تحميضه بين الحين والحين ليستعمل الصورة في الوثائق الرسمية، حتى راحت الدوائر الحكومية تطالب المراجعين بصور ملونة وحديثة، ثم تولت بنفسها أمر الصور فصارت تلتقطها فوريًّا من دون مبالاة بامتعاض الناس واستنكارهم لبشاعتها. يبدو أبي في صورة الترخيص شديد الوقار كما يبدو في الواقع، ولو كنت أعمل في تراخيص الأسلحة لمنحته الترخيص من دون حاجة إلى التحقق من استيفائه للشروط، فالرجل يبلغ السن القانونية، ولا يشكو في الظاهر من مرض نفسي أو عصابي، وليس في هيئته الرزينة ما يشي بحكم جنائي أو قيود أمنية. تلك هي الشروط الثلاثة اللازمة للحصول على ترخيص لحمل السلاح.
ومن سيطلق الرصاص على كل حال لن يكترث سواء أكان السلاح مرخصًا أم غير مرخص، بل إن اقتناء السلاح في حدِّ ذاته ترخيص شخصي. ثم كيف يميِّز العاملون هناك الأمراض النفسية ما لم يتقدم إليهم المرء بتقرير معتمد من الطب النفسي، ولا أظنهم يفعلون ذلك. وإن كنت للأمانة أعتقد أننا جميعًا نشكو من أمراض نفسية بدرجة أو بأخرى. نخفيها أو نتعايش معها، ومن لا يستطيع يُساق إلى المصحة. على أن ذلك الموظف في إدارة التراخيص قد أخطأ كما أنني سأخطئ لو كنت في مكانه، إذ لم يكلِّف نفسه عناء البحث والتدقيق في سجل أبي الذي كان مستوفيًا الشروط باستثناء شرط الحكم الجنائي.
كان أبي قد أطلق في يوم بعيد خمس رصاصات على رجلٍ ما!