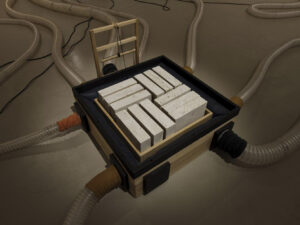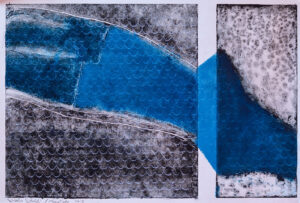متحيرًا بين الوصال والانتقام، ينتظر شهاب موعدًا غراميًا بعد ثلاثين سنة من آخر لقاء، من بدت له قديمًا أنها حب العمر، تبدو الآن مصدرًا للتوتر والتفكير العميق.
أحمد الفخراني
وصل قبل الموعد بساعة، لكنه لم يدخل إلى الكافيه مباشرة، بل حام حوله من الخارج عدة مرات، كلص، كمترصد، كمجنون، ليتأكد عبر واجهته الزجاجية أنه مسرح مناسب لعرضه القادم، حتى لفت نظر العاملين في المكان وشرطي مرور وبائع صحف ومتسولة تدعي العمى، فاضطر إلى الدخول، وجلس على أول طاولة وجدها.
لم يكن شهاب جعفر، لصًا أو مترصدًا أو مجنونًا، بل رجلًا مرتبكًا في الخمسين من عمره ينتظر أن تفرغ واحدة من تلك الأرائك الكبيرة التي حجزها العشاق بالكامل. وليس أدل على ارتباكه، من أنه كان بإمكانه أن ينتظر من البداية في الداخل، ثم يبدل مقعده ما أن تفرغ أول أريكة.
جلس في الناحية التي تمكنه من رؤية البحر الممتد على الضفة الأخرى من الشارع. لم تكن الأسوار الحديدية قد ارتفعت بعد على كورنيش الإسكندرية، لتحجب امتداد البحر عن مرمى البصر، فتحبس سكان المدينة البائسة داخل الحقيقة وحدها، قبيحة عجوز، عارية من السحر والأمل وأوهام التاريخ، لكن نذر ذلك السجن ونية سجانه كانت قد ظهرت واضحة، ولم يرَ فيها شهاب شيئًا سيئًا، بل درسًا ضروريًا سيكون مؤلمًا بعض الشيء في البداية، كشأن الدواء المر.
فكر شهاب أن كل ظاهر، مهما بدا شفافًا كسطح الواجهة الزجاجية للكافيه وسطح البحر مجرد خدعة، وظيفته الإلهاء عن النظر، أما الباطن فليس إلا خدعة أكثر تركيبًا، ساحر فقط لأنه غامض، لكنه لا يخبئ بالضرورة كنزًا أو خرافة ملهمة، قد لا يخبئ إلا وحشًا قميئًا ضاريًا أو جبلًا من النفايات، نفايات الناس والذاكرة.
طلب قهوة تركي سادة بلا تحويجات وزجاجة مياه، بينما ينتظر امرأة على طاولة محاطة بعشاق كاذبين، كأنهم مرايا ضاعفت من شعوره بهشاشة خطته. لقد استهدفوا ما استهدفه، ليلة في الفراش يتوسلونها عبر ادعاء الحب، لكنه ليس مثلهم، قال لنفسه.
كان قد قابلها هنا في آخر لقاء بينهما، ورأى أنهما لو كانا قد جلسا على واحدة من الأرائك الأربع الكبيرة بما يكفي لالتصاق جسدين نصف محجوبين عن أعين العاملين والزبائن، لتمكن من قرص ثديها أو اعتصاره، وأن يداعب بأصابعه فخذيها وصولًا إلى ما بين الساقين، مغارة الملذات المهجورة.
بالنسبة لشهاب، تلك ليست سوى عقبات تافهة ومهينة، لا تهم سوى مراهق، كل ما يعنيه أن يحصل على علامات صلبة لا يمكنها التشكيك فيها أو التراجع عنها، بحجة أنه قد خُيل له.
إذا سمحت له بتجاوز هذا كله، ثم رفضت عرضه، سيوقن أنها خدعته قبل ثلاثين عامًا، لما أنكرت علامات واضحة جعلته يعترف لها بحبه وهو طالب في الجامعة لظنه أنها أيضًا تبادله الحب.
أخبرته أنه أساء فهم إشاراتها، وأنه مثل كل شخص حولها، لم يستقبل انفتاحها الحي والمتفائل على العالم ببراءة، لتحيط رقبته بذنب حياتها الذي لا علاج منه، لقد جرته بغوايتها إلى فخ، ثم امتلكت بعد ذلك الجرأة والوقاحة لتقتحم حياته لتفسدها عليه من جديد.
يؤمن شهاب أنه إذا أمسك بيقين كهذا، سيحظى أخيرًا بجرح مفهوم، جرح قابل للشفاء.
امرأة رفضته في الماضي؟ ما الاستثنائي في الأمر؟ قصته كشأن كل قصص الحب، محض تفاهة مضخمة، ثرثرة ومناجاة، لا شيء فريد فيها، كما يؤمن شهاب.
قصة كان يمكن لها أن تمر على الملايين سواه، دون أن تترك ذلك الأثر، الذي لم يدرك كيف تحكم به وصاغ حياته، إلا بعد ظهورها من جديد، بعد ما ظن أنه تحرر منها ومن ذكراها.
لم يحكِ حكاية حبه المجهض لأحد، لا على سبيل المأساة أو النكتة، فالشيء الوحيد الذي يحمي تلك الحكاية من تفاهتها هو أن تبقى مكنونة كسِّر في القلب، لكن من ناحية أخرى فلا سبيل لإيقاف تضخم أثرها كوحش يتغذى على آلامه، ويبتلعه في جوفه إلا أن يرويها، لكنه يفشل في كل مرة في أن يقصها على أحد.
كيف يمكن أن تحكي عن شيء له كل هذا الأثر داخلك، دون أن يجرحك من يستمع بحقيقة تفاهته، دون أن يخبرك مستخفًا، وهو يظن في الآن عينه أنه قد وجد التعبير الملائم لجبر كسر قلبك: «معلش».
تأمل وجوه العشاق اللذين احتلوا الأرائك. تراوحوا في العمر بين سن المراهقة ومراهقة منتصف العمر، لا فارق يذكر، في الحالتين يجعلك الحب أبله، فاقد التمييز، مسلوب العقل والإرادة، طفل متقلب، أناني، تخلط الشر بالبراءة، وأشد الرغبات قتامة بزرقة السماء، يمكنك بفضله أن تحرق المدينة على أنغام أغنية حلوة، أن تمرر سكينًا فوق عنق، وأنت تتقلب فوق غيوم الوجد، لأنك لن تعرف الفارق بين الأحقاد والأشواق.
لا تنسَ، يذكر العقل كل عضو خائن خائر العزم في جسده. أنت لا تحبها، بل مجرد مجروح يبحث عن خاتمة، أجمل نساء العالم مختلقة بالكامل، لذا ففي كل مرة تنهار الرؤى، ولا تبقى سوى حقيقتها المضنية: عفن وخواء.
امرأة كنصل موس صدئ، تلك حقيقتها، بأسنان أكلها التدخين وأنف معوج، جسد تحطم، ثديين مترهلين، عين شاردة وإيقاع مفقود، في التاسعة والأربعين، ولم يتبق من مشمشها إلا العطب، بين نوبات الإنكار والهيستيريا قد تظنها شخصًا عاديًا لم يسحقه الزمن.
أول من منحته فكرة عن الفردوس الكامن في أن يبادلك أحد الحب، انكشف له مسرح اللذات، ومن على الأعتاب طُرد، ملعونًا بعذوبة الرائحة التي أسرتها أنفه طويلاً كأنها قارورة عطر. يؤمن شهاب أن ما سلبه إياه الحب هو عدم قدرته على التعرف على نفسه كضحية، بل اعتنق اتهام مفترسه له بالظلم، أن النقيصة تخصه، وأنه رُفض لأن وجوده نفسه ملعون من البداية.
المضحك في رائحة الغواية أنها لم تعد تصدر عن الفتاة القديمة في الجامعة، بل عن امرأة تتعفن أجزاءها كسمكة نتنة، بالضبط، سعد بأنه قبض على الرائحة، الفسيخ، الفوح المدوخ لبرميل قمامة تخمر.
لا بد أن تلك العفونة تلاقي شيئًا ما في قاع روحه، فأعاد أنفه نسجها كمسك وعنبر، حتى يتحمل الغوص داخلها، لكن تنكر الرائحة لم ينجح إلا في حرمانه من التنفس، لم يبق في قارورة أنفه سوى العطن، ربما لأن غرامها لم يكن حقيقيًا قط، لا سحر بمغارة فرجها، سوى أنه حرم عليه، وكان مفتتحًا لسيرة من الصد والهجران والشك في كل قبول وكل جسد ناله.
اسمها سارة، ولم تعد حلوة، وفي شبابها كانت تكتب الشعر فيخرج ركيكًا، تغني فيصدح النشاز، لوحاتها طبق فاكهة رخيص في صالون، لم تلتقط بالكاميرا إلا العادي والمكرور، فازت بأوسمة العور في نوادي العميان، لكنها في أيام الجامعة، كانت اللوحة، القصيدة، الأغنية، لقطة الكاميرا المذهلة، الحب، الشهوة، الدنيا مصرورة في منديل، ملهم لا صانع، يُعاد خلقها، لكنها عاجزة عن خلق شيء.
في زمن ما كان يؤمن أن بصيرتها ثاقبة، تقرأ الأرواح كمن يقرأ الجريدة، تلتقط النغم المعقد للنفوس كمن يدندن بأغنية حلوة، هي فقط لا تجيد التعبير إلا بالثرثرة لا الفن، حتى إن تلك الميزة الرهيبة لم تجلب لها إلا الضرر. إذا تحدثت، ليس بإمكان أحد أن يوقف ذلك النشيج الذي يختلط فيه الولع بالغضب، كصوت أطباق تتحطم في ظاهره، أما في باطنه فهو صوت امرأة تدندن بأغنية، وهي تسقي الزهور، ووحده يدركه. هل يدركه حقًا أم يتخيله؟
هذا هو كل ما تعنيه له، الرفض، النبذ، الخذلان.
وما جاءت إليه الآن بعد كل تلك السنوات إلا لتفتش في دفاترها القديمة عن شاعرها الذي هجر الشعر بعد أن انكشفت له فداحة الكذبة، ما تعرضه عليه هو حيلة المهزومة، بعد أن انفض الجميع من حولها، لتستعمله ثم ترميه بلا قطرة وصل واحدة، لتخدعه ثانية. كل ما تريده هو أن تشعر، ولو كذبًا أنها ما زالت مرغوبة كما كانت حين كانت شمسًا تدور حولها الأفلاك، وفي سبيل لذلك لن يعنيها أي حياة تُحطم.
امرأة ستأتي بعد قليل بالتواضع الكاذب لطاووس والزهو المقيت لضحية، وحدها بإمكانها أن تصنع ذلك الخليط من الاستحقاق والشعور بأن العالم قد خدعها. لم تفكر يومًا أنها قد حصلت على ما دفعت ثمنه، خدعة بخدعة. وهو أول المخدوعين لولا أنه لم يحصل على انتقامه بعد، ولولا أن في قلبه شيئًا يحاول أن يثبت أن ذلك الجرح الغائر لم يكن توهمًا منه. لولا ذلك الأمل الضئيل، لما رآها مجددًا، وما منحها الفرصة الأخيرة للغفران أو الانتقام.
تخيل المشهد، وهي تجلس أمامه بالعين المبتذلة للغواية، كما حدث في اللقاء السابق قبل يومين، احتضنت يديه كأنها عاشقة ذوبها الغرام، وعندما تجرأت تلك اليد، ومرت فوق خدها تمسحت بوجهها فيه كقطة، فتجمد مكانه مذهولًا مما سمحت به، ألمحت دون أن تؤكد – كعادتها – أن كلامها موجه عن حاجتها إلى قبلة وعناق.
قبلة وعناق!! لم يعد طفلًا، وعرضها – إن صح – ليس إلا إهانة. بعد كل تلك السنوات لن يرضيه سوى ليلة كاملة، هذا اختبارها الأول والأخير.
بعد أن يلتقط العلامات الصلبة، سيعرض عليها ليلة في الفراش، رغم علمه أن لا شيء تبقى من أنوثتها سوى حطب جاف. إن وافقت، سيغفر لها ظنه القديم، وسيعتبر المسألة كلها حكاية بين اثنين ناضجين، أهدرا عمريهما قبل أن يستقرا على الوصال. إن رفضت عرضه أو كذبت ما لا يمكن تكذيبه، سيكون العار والذنب كله – أخيراً – في رقبتها لا رقبته.
كان يعلم في قرارة نفسه أن خطته ليست نبيلة، وأنه يستغل ضعف امرأة ويأسها بعد أن تخلى عنها الجميع، لم يفكر في المسألة من تلك الزاوية، واستسلم لحيل عقله التي أخفت تلك الفكرة بعيدًا، ليس فقط لدناءتها، لكن لأنها مهينة له شخصيًا، فالفرصة الوحيدة المتاحة له لكي تقبله امرأة رفضته قبل ثلاثين عامًا، هو أن تكون على حافة يأسها. وهو أمر يجعل منه كل ما تجنب أن يكونه، لصًا ومترصدًا ومجنونًا ونذلًا ومسكينًا يملك خطة بالغة التفاهة والشر.
كان الحل الوحيد لديه ليتجاوز ما حدث، هو أن يحسم كل شيء معها في تلك الليلة، هنا والآن، لكنه لا يعرف ما يريده بالضبط، الانتقام أم الوصل؟ هل يغفر لها لو كانت بالفعل قد خدعته في الماضي، لكنها الآن جاهزة لتصير حبيبته؟
حتى لو ذهب إلى فراشها، لن يعيد ذلك إليه حياته. دون رد عادل لن تستقيم له حياة، عندما تتعرى أمامه، لن يمنحها الحب، بل سيترفع عن جسدها المنهار المتشقق والجاف، ثم يواجهها بكل ما سببته له من آلام، لا، بل ربما عليه أن يضاجعها أولًا، ثم يغادر دون أن ينبس بحرف، بعد أن يطعنها بنظرة أخيرة تحمل كل ما يكنه تجاهها من غضب واحتقار، نظرة هي آخر ما ستراه من وجهه قبل أن يهجرها إلى الأبد، ستكون مزلزلة حد أنها سترافقها حتى نهاية حياتها كجرح مفتوح غائر، كندبة لا تحتمل.
كان ليفر ويغلق الباب أمام عودتها لولا أن للحنين وهجًا يثير في البدن رجفة البرد. الشهوة تتفتح مسمومة بالحقد. غواية الانتقام، لم يعد لها لهيب الكراهية، بل رائحة الزنجبيل وهدأة السكينة.
في ارتباكه بين الوصال وتفاهة الانتقام، التسامي وخسة الأفكار، الإيمان بالغرام والكفر به، يلعنها ألف مرة، لكن أليس ذلك هو الحب؟
لكم تمنى أن يتحول طيفها من وحش يقض مضجعه، إلى ونس. ربما كانت تلك الفكرة هي الثغرة التي تسللت منها إليه، بعد أن انقطعت علاقتهما لسنوات، كادت فيها صورتها أن تتلاشى من مخيلته، وتبتعد كسراب حزين، حتى إنه كان يواجه صعوبة في تذكرها، استدعاها بغواية أن تكون تلك الصورة التي سيصنعها لها ملكه وحده، نسخة منها ليس بإمكانها أن ترفضه فيها، أو ربما تملكه الذعر من تلاشيها من ذاكرته، ليس عن حب، قال لنفسه، بل خشية من أن تخلصه من حضورها في مخيلته، قد يجعله يقاسي بذلك كل ما عاناه من آلام الهجران من جديد.
لذا أعاد تشييد صورتها من هشيم ورماد وغبار ونثار ورود، من حطام امرأة ووعود مسحوقة، وصارت تلك الصورة هي ونسه الوحيد، في كل مرة يلقي فيها رأسه على الوسادة كحجر مثقل بالوهن والخوف والظلمة، تأتيه سارة كثمرة ضوء مرة، فيعض على صورتها الجفنين، لا حيلة له سوى إمعان النظر.
هكذا تنهض على يدي خياله، أجمل نساء العالم وخلاصة أريجهن تصير، عارية بين ذراعيه بجلد ناعم، فيستشعر غليان الدم والأشواق. لذتها معين لا ينضب، بل هي منبع كل لذة، يختفي وهم الخشية من أن يُلمس وانغلاق جسده على نفسه، ويدرك أن دواءه هو نفسه علته، حيث لم يعد يتحرك فيه أي شيء نشطًا وعفيًا، إلا عندما يفكر بها، كميت بُعث من رقدة حواسه البليدة وجسده الذي لم يعد يستشعر الحياة إلا عبر صورتها، يتساوى في ذلك الاشتهاء والغضب. يستعيد عافية حواسه كمن يتعلم من جديد كيف يبصر، يشم، يسمع، يلمس، يتذوق.
يتذكر الصدفة المروعة التي اكتشف بها أن تذكرها يحييه، وأن ما ظن أنه تجاوزه، لم يكن إلا نارًا مخبأة.
كان عائدًا من شهر عسل زواجه الثالث، بالسخنة، وكان قد خسر في سبيل ذلك الزواج احترام أقاربه وجيرانه ومعارفه، اللذين ثبتوا سمعته، كعجوز متصاب، تزوج بصديقة ابنته التي تصغره بثلاثة وعشرين عامًا، وكذلك خسر فرصته الأخيرة مع ابنته، التي لم تسامحه قط على طلاق أمها، ولم تفهم سر شغفه الفضائحي بالنساء، وظنته مثل الجميع تصابيًا، لا بحثًا عن سر وترويضًا لوحش.
لا يعلم كيف طور تلك القدرة على الغواية بقلب مكلوم وجسد منكمش فاقد لليقين في نفسه، كلما أقنع امرأة بجدارته، فقد ثقته بجدارتها، أو شكك أن في الأمر خدعة، هكذا فاته الحب طيلة حياته، وبالنسبة له تحول الغرام إلى عاصفة خرافية لا قبل له بها.
كان يأمل أن تنقذه رفيدة بجسدها الشاب، النضر والحساس، أن يلهم شبابها شيخوخة حواسه، وأن ينفتح من جديد على جسده، وكان يظن أن السن هو علته، لكنه أخطأ التشخيص، فبعد أقل من أسبوع من فرح جسده ونشوته بها، حتى عاد إليه انكماشه المذعور، عاف ذلك الجسد، مارس معها الحب كموظف أو عجوز رأى كل شيء، فلم يعد يبهره شيء، انكشفت لرفيدة خديعة الدون جوان المزيف، كازانوفا الذي بلا أجنحة.
بطريقة ما فهمت رفيدة أن جوفه يحمل أنثى سواها، لقد أدركت ذلك قبل أن يدركه شهاب بحدس النساء.
في الحافلة، وهو نصف نائم، استدعى صورة سارة، ضاجعها في خياله للمرة الأولى، وكانت حلوة ندية، وشعر بارتعاشة الحياة المنعشة تُبث في عروقه وقضيبه، لكن الجميل حقًا أنها كانت أيضًا سعيدة، ترتجف مع كل لمسة، ويطيران معًا إلى أقاصٍ غير مكتشفة من اللذة، بعد أن وجدا أخيرًا العنصر المفقود. ارتج هاتفه، أفاق، فلما ميز الصوت، أطاحت به رجفة الذعر من سماوات أحلامه، كان كمن استدعى الشيطان غافلًا.
– إزيك يا شهاب؟
كانت رفيدة غارقة في النوم، فقال مسلوبًا بصوت هامس: «بخير.. وأنت؟» ولم يتفوه بعدها بحرف، بل ظل يستمع لذلك الصوت، يتحرى فيه أثر الفِراش الوثير.
أخبرته أنها داخت حتى وجدت رقمه، بعد أن قطع علاقته بأصدقاء الشلة القديمة، وأنها ستترك أخيرًا بيت أمها بالمنصورة، هربًا من جنونها وخذلان شقيقتها، وأنها لم تجد سواه ليساعدها على البحث عن سكن في الإسكندرية، وأشياء أخرى توقّف عن سماعها ليسرح في فكرة ساذجة أن سارة، وهي ذات الحساسية العالية، قد شعرت بما حدث، أن جسديهما قد تقلبا معًا للتو فوق السديم الغائم للأحلام، حيث تتلاقى الأرواح. وقد هاتفته لأنها استشعرت الشيء عينه، غليان الدم والأشواق، وها هي تقرر العودة، لم تختر أي مدينة أخرى إلا بجواره. كان ذلك قبل أن يعرف أنها لم تعد من أجله، بل من أجل عشيقها المتزوج، الطبيب الذي رشحها أيضًا للعمل في إحدى المستشفيات بالإسكندرية.
وصلت مع الطبيب إلى النهاية المتوقعة، وكشأن أي رجل في مصر، قدم الوعد الكذوب عينه الذي لا تقبله إلا مغفلة تتواطىء بكامل إرادتها كي تعمي عينها عن الحقيقة، لن يترك زوجته وأبنائه كما وعد، ومن أجل من، امرأة محطمة تودع أنوثتها؟
أراحه لكن لم يشفه أنها ذاقت الخداع، هل أذلها أخيرًا الحب المستحيل، أم اليأس من العثور عليه؟ هل راوغها ذلك الطبيب طويلًا، قبل أن يهجرها بقسوة وبعد أن تأكد أنه امتص ثمالة ما تبقى من رحيقها؟
ها هو هنا الآن عالق في انتظارها، لا يملك سوى خطة هشة كي يجد خلاصه من تلك الحكاية التي ابتلعت وجوده، وجعلته يسير كالنائم مدفوعًا بهوس تافه لتكرار الأمر نفسه من جديد، عله يجد خاتمة أخرى، مرصودًا للتيه حتى الموت من حب إلى آخر بحثاً عن إجابة عن سؤاله: ما الغرام؟
سؤال بسيط ومطلسم، كنور أبيض محاط بغلالة شفيفة من الظن وسوء الفهم، حيث كل إجابة هي سراب، وكل يقين ليس سوى مزحة ثقيلة.
– وحشتني.
فحت بها بالقرب من أذنه، فكاد أني يبكي مذعورًا من رهافة الشوق وكراهية أن يحدث ذلك كله، أن يشعر برعدة عصفور أخرق، الوله كمغفل أمامها، وقد باغته مجيئها، دائمًا من الخلف، كأنها تنبجس من ظلام حلم غائم، من هاوية تهيم فوق رأسه، فلا يعرف إن كان لمفاجئتها حلاوة لعبة الغميضة مع محبوب يتدلل أو غدر الطعنة.
يلتفت فلا يرى سوى ابتسامة حلوة فوق شفتين فاتنتين ووجه يرتد إليه شبابه وجسد يختفي انهياره، لكم يكره هذا القلب ذي العين الكذوب الذي يعمى عن أحقاده كأنها لم تكن فور أن يراها، ولا يبصر فيها سوى أوهام الليالي والأمنيات القديمة.
إذا أرادت خداعه، فليست حصونه إلا ثغرات مفتوحة بكامل إرادته المسلوبة؛ لأن شيئا ما في داخله يتمنى لو أن وصلا حقيقيا قد يحدث، فيضيء ظلمة روحه، المكسوة بالصدأ، أما عقله فينزوي نداءه، وتتضاءل مهابة صيحاته كحارس أمين، إلى ذبابة مزعجة تطن في رأسه، ود لو طحنها بيديه.