
كل شخصيات الدولة اللبنانية بقضّها وقضيضها كانت بانتظار انتهاء مناقشة أطروحة غزالي كي يمطروه بالتهاني والتبريكات.
فوزي ذبيان
استفقتُ على صوت متقطع لساكسوفون ينطلق من المبنى الذي يقع تحت المخفر، إنه مبنى الكونسرفاتوار (المعهد العالي الموسيقى). نعم، فمخفر الرملة البيضاء يشكّل الطبقة الثانية من مبنى يحتل الكونسرفاتوار طبقته الأولى في الجهة الشرقية من مبنى الأونيسكو. لم يزعجني الصوت البتة بل لقيتني محل رخرخة لم تكن في الحسبان.
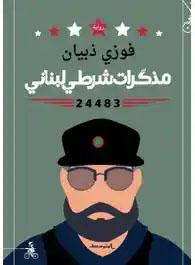
سألتُ مرة عن رسوم التسجيل في هذا المعهد وفي بالي دراسة العزف على الساكسوفون إنما وللأسف الشديد طوشة الأيام وزحمتها دفشتني بعيدًا عن هذا المبتغى وأنا حتى اليوم نادم لتقصيري بحق نفسي في هذا المحل بالذات… نيتشه، وهو أحد أصدقائي في قسم الفلسفة وفي الحياة يقول أن العالم بلا موسيقى هو خطأ فادح وأنا أوافقه الرأي.
كانت تتناهب أذناي أصوات الساكسوفون من جهة وأصوات جلبة تتسرّب من تحت باب غرفة النوم من جهة أخرى ليُفتح بعدها هذا الباب بعنف وبحركة تشوبها معالم الإستعجال وأنا كنت بين اليقظة والنوم.
أشار عليّ الرقيب أول «أبو قرصة» كي أنهض وأرتدي ملابسي العسكرية بسرعة.
لا يدعى «أبو قرصة» إنما هو لقب تلبّسه وقد باغته أحد العناصر في الحمام وهو يقوم بقرص رقبته عبر أصابعه إلى حد الإحمرار، فـ«أبو قرصة» لم يكن يجيد استمالة الفتيات شأن زملائه الدركيين فعمد إلى حيلة تشي أنه بخضم علاقة جنسية مع فتاة شرسة تعضّه في رقبته وفي أنحاء أخرى من جسده أثناء ممارستهما للسكس… ومن تلك اللحظة صار لقبه «أبو قرصة».
استشاط غضبًا على زميله الذي قد أفشى سرّه ثم كفّ عن قرص نفسه إنما لقب «أبو قرصة» محق اسمه الأصلي فصار لا يُعرف إلا بالرقيب أول «أبو قرصة».
ارتديتُ ملابسي بسرعة البرق وتوجهت مع مجموعة من عناصر المخفر كان على رأسها الرائد رئيس المخفر إلى جامعتي، بل إلى كلية الآداب!!!
كانت الكلية تغصّ بالسيارات بما يفوق العادة بكثير وثمة شخصيات سياسية كانت تتوافد إلى المكان بكميات هائلة… «العمى، شو في!!» قال الرائد كمن يكلّم نفسه وأنا أيضًا كنت طائش اللب حيال ما يجري هنا، فمنذ تواجدي في هذا المكان كطالب فلسفة لم أعهده مزدحمًا بهذا الكم من الناس والسيارات والرانجات الداكنة الزجاج.
لم يخبرنا حضرة الرائد عن طبيعة المهمة وكان وجهه ينمّ عن وقع مفاجأة لم تكن في الحسبان… حسنًا، إنه العميد رستم غزالي يناقش أطروحة دكتوراه في التاريخ هنا في كلية الآداب وفي قاعة نزار الزين في وسط الجامعة التي كانت تعجّ بالسياسيين اللبنانيين ورجال الدين بما لم يكن في التوقّع، فكل هؤلاء أتوا لحضور مناقشة غزالي!

مجموعة من شبان جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية كانوا يعملون على تأمين حركة المرور وركن السيارات وثمة الكثير من الهرج والمرج والفوضى كان يسود المكان.
«… والله يا سِيْدْنا ما معي علِمْ، ما حدا خبّرْني»، كان الرائد آمر مخفرنا يحاول تبرير حضوره المتأخّر مع مجموعة دركييه عبر جهاز الإتصال في آلته العسكرية ولم أدري مَنْ كان على الجهة الأخرى، ربما العميد قائد شرطة بيروت أو اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي بل لعله وزير الداخلية.
استبدل الرائد إطلاق الشتائم بسبب ما تعرّض له من إهانات عبر هذا الإتصال بتمتمات كانت يتوجه بها إلينا تفيد بأنه علينا الإنتشار بسرعة في المكان.
تعطّلتْ الدروس في الجامعة في ذلك اليوم وثمة الكثير من الشخصيات كانت تذرع أرصفة الجامعة جيئة وذهابًا بسبب تعذّر قاعة المناقشة عن احتواء الجميع، فكل شخصيات الدولة اللبنانية بقضّها وقضيضها كانت بانتظار انتهاء مناقشة أطروحة غزالي كي يمطروه بالتهاني والتبريكات. ثمة من كان منتظرًا داخل سيارته أو في الردهة الداخلية للمبنى الذي يضم قاعة نزار الزين فضلًا عن أولئك الذين قد افترشوا الأرصفة عبر نعالهم التي تشبه وجوههم ولا مبالغة في هذه الإستعارة على الإطلاق.
«أيري بهل دولة»، قال أحد الزملاء وهو يرتشف القهوة عبر كوب من البلاستيك لأرد عليه وأنا أتأمّل الوجوه القميئة لرجال الدين والإعلام والسياسيين الذين قد عبّوا المكان عن بكرة أبيه، «… وأيْرَيْن».
من باب الحشرية حاولت التسلل إلى القاعة التي تحوي رستم غزالي والدكتور الإيّاري الذي أشرف على الأطروحة وبقية أعضاء لجنة المناقشة إلا أن بعض عناصر جمعية المشاريع (الأحباش) تصدّوا لي وطلبوا مني بكل أخلاق أن أبقى في الخارج على الطريق العام، فامتثلت لأوامرهم بلا مبالاة.
كان الرائد داخل آليته العسكرية يحتسي القهوة بعصبية بارزة وملامح البهدلة التي أكلها لم تكن قد انزاحتْ بعد من فوق قسماته. أخد رفاقي في الكلية من اليساريين وغيرهم ينقّرون عليّ وإحدى الصديقات من جماعة الأناركيين مّرت بقربي وقالت لي بعلي الصوت: «رِيْتَكْ تؤبرني إنت ورستم غزالي يا وَطَنْطَنْ» بادلتها ضحكها وقلت لها: «طيّب انفخيييه»، وكلمة «انفخيه» لا سبيل إلى شرحها أما القراء من اللبنانيين فسوف يفهمون عليّ.
لا أذكر كم من الوقت استمرّتْ تلك المناقشة لكني أذكر أن الضيق يومذاك أخذ بمجامعي إلى حد التلف إذ غالبًا ما كنت أتجنّب مجرد الحضور إلى الجامعة ببزة الدرك فكيف والحال أني مغبة مهمة خرائية تتعلق بأطروحة دكتوراه خرائية وبحضور كمية هائلة من السياسيين ورجال الدين والإعلاميين الخرائيين…
إن ذلك اليوم الذي ابتدأ بهمس رائع لساكسوفون تحول في حياتي الدركية إلى يوم خرائي بامتياز.

