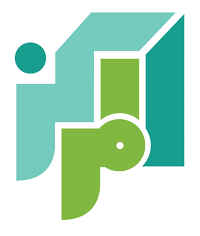ننشر مقتطفًا من رواية «صلاة القلق»، إحدى روايات القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية للعام 2025، حيث يحكي محمد سمير ندا «في إطار فانتازي يزاوج بين التاريخ الحقيقي الموثق، والخيال المحض، يجاري الحقائق ويسخر منها» عن زمن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ودولته وشعبه.
محمد سمير ندا
سهم الله في عدوّ الدين
استيقظَ الشيخ أيّوب المنسيّ صباحَ اليوم، فلم يجِدْ رأسَه بين كَتفيه.
نال منه الوباء، فحوّلَ رأسَه كتلةً عظميّةً جرداءَ خلَتْ من الشعر، وبدَتْ أقربَ إلى هيئة الحصى منها إلى رؤوس البشر، بينما احتفظَ جسدُه الطاعن بقوامٍ بشريٍّ يحاكي في خموله السلاحف، من دون أن يمتلك درقةَ الوقاية.
عرف الشيخ قبل ليالٍ أنّ شيئًا قد تغيّر. أدرك أنّ خللًا حلَّ بنسق الحياة في النجع، وراحت حواسُّه تبثّ شعورًا مطّردًا بخطرٍ مُحيقٍ منذ سقوط الحجر الناريّ على بعد كيلومتراتٍ من المكان. حدث ذلك قبل أماسٍ عديدة. يومئذٍ أضاء الانفجار السماء. مزّقَ الحَجَرُ سُحبَها، ونثر النجمات فما عُدنَ يتراصَصن في مواضعهنّ التي رسمَها الأجداد؛ خبتْ أنوارها فازداد اللّيل حلكة، وهجرت الطيورُ الناعسة أغصانَ التوت والجمّيز. وشابت أغصان الصفصاف وترنّحت سوق النخل.
أحدث الانفجارُ دويًّا هائلًا، فخيّمَ الصمتُ على رؤوس المارّة والقُعود، ورجفت القلوب، وتوقّف كلّ شيءٍ في تلك الصحراء المدجّجة بالألغام. لكنّ بضع شظايَا تطايرت على مقربةٍ من الدور، فأمستْ قِبلةً للناظرين وسيرةً للحكّائين.
فهم أيّوب أنّ ذاك الدويَّ الهائل قد يكون سببًا في ما استجدّ على الناس من أعراضٍ مرضيّةٍ لم يعد بالإمكان غضّ النظر عنها. فقد استفحل الوباء حتّى نال من الشيخ نفسه في غضون أيّام، هو وزوجته وبناته الخمس. أقضَّ القلقُ مضجعَ أيّوب ابن الوليّ جعفر، حتّى تشابه عندَه اللّيل والنهار.
طالت اللّيالي كأنّها ليلٌ واحدٌ ممطوط. وشعر الشيخ بأنّ ثمّة أمرًا جللًا يمنع الشمسَ عن البزوغ، فظلّ يناجي الله أن يهبه كرامةً من كرامات أبيه.
كان يقف أمامَ جلباب أبيه الملطّخ بالدم، ويستدعي زمانًا ولّى. يتذكّر الضجّةَ المغلّفةَ بغبار الراكضين خلف عِجلٍ ضخمٍ هاربٍ من سكّين الجزّار في قريةٍ تتاخِم النجع القديم، وأذناه تضجّان بصخبِ ذلك اليوم، من صياح صِبية الجزّار، وتدافع الأهالي إذ انضمّوا إليهم في مطاردة العجل الهارب. لقد قطعَ بهم الطرقات والأزقّة حتّى وقفَ أسفلَ دار الشيخ جعفر.
يومئذ، علتْ نداءات الناس، أخذوا يطالبون بإطلالةٍ مباركةٍ من الشيخ العائد من الموت. كان يعرف أنّ أبَاه باتَ يهذي أغلبَ الوقت، وأنّ عقلَه فقدَ الصفاء الذي سبق ميتتَه الأولى. حدّث أبَاه بما يجري. وطلب منه تلبيةَ النداء الصاخبِ أسفلَ الدار. فاتّكأ الشيخُ على ساعده الأيمن ومضى معه. لم يعلّق، كأنّ الأمر لا يعنيه. هبطَا الدرج، فوجدَا العجلَ يقف حذوَ مدخله في قلق، كان مذعورًا يضرب الأرض بقوائمه، وقد نضبت في عينيه مسالك الهرب.
أقبل عليهما شابٌّ، وناولَ الشيخَ جعفر سكّينًا، ثمّ ترجّاه أن يذبح العجل الشاردَ. لكنّ الشيخ طلَب كوبًا من الماء، ولم يعلّق. فهرع أيّوب إلى الطلمبة[1] خلف الدار. وحين عادَ بالكوز المعدنيّ؛ وجدَ العجل خائرًا، والسكّين في يد أبيه. بدا له غارقًا في نوبةٍ من الدهشة والذعر، وقد اكتسى جلبابُه بلون الدم، بينما كان الناس يكبّرون ويهلّلون، ويتنافسون على تقبيل يد الشيخ المبارك ولحيته وكتفَيه. كانوا يتسابقون إلى غَمْس كُفُوفهم في جلبابه المضرّج بدم العجل الذبيح. وتحدّث بعضُهم أنّ العجل ألقى بنحره على السكّين في يد الشيخ فخرّ ميّتًا، وبرعُوا في سرد تفاصيل عن نظرته الراضية وخواره الأخير، وعن قوّة الشيخ إذ ظلَّ مُنتصبًا في محلّه على الرغم من انقضاض العجلِ على مجلسه. لم يتحرّك الشيخُ الطاعن، بل كان يهذي بكلامٍ غير مفهوم، وينثر لعابَه، ويومئ برأسه إلى مريديه.
تلك واحدةٌ من معجزات أبيه. فبعدَ مَوْتته الأولى والثانية صار وليًّا تُحمَل الشموعُ إلى جوار ضريحه في الجبّانة[2] مساءَ كلّ جمعة. لم يفهم الشيخ أيّوب ما جرى يومئذ، بيد أنّه ظلَّ يحتفظ بالجلباب. ولم يغسله، بل علّقَه لاحقًا في موضعٍ بارزٍ من مضيَفة أبيه، إلى جوار صورته الفوتوغرافيّة الضخمة في زيّ الإحرام. كان الزائرون يتبرّكون بذكرى الجلباب وسيرة الواقعة، ويقفُ هو أمامَه بين حينٍ وآخر، فيستدعي حيرةَ ذلك اليوم، كأنّ العجل ذُبح الساعةَ.
يشعرُ بأنّ النجعَ في حاجةٍ ماسّةٍ إلى معجزةٍ مشابهة، قوّةٍ صافيةٍ خارقةٍ تعيدُ النجمَ السّاقطَ إلى موضعه في صدر السماء، أو تردّ القذيفةَ الضالّة إلى مدفعها. إلّا أنّ خليل الخوجة، الممثّل الرسميّ ﻟنجع المناسي، أذاعَ أمرًا آخر وهو في مجلسه مع مريديه. ففي داره الشرقيّة -على مقربةٍ من مطبعته العتيقة التي تنقل الكلامَ المسموع إلى ورق ملموس- صرّح نقلاً عن الجهات الحكوميّة المنشغلة بحربٍ ضروسٍ تأبى رحاها أن تتوقّف عن الدوران منذ عشر سنوات، فقال إنّ السقوط لم يكن لقذيفةٍ أو صاروخ. ثمّ عادَ وأكّد أنّ الحرب لن تصلَ إلى حدود النجع المزروع في خاصرة الصعيد، ولو طالت آمادُها عشرات السنين.
هذا الرجلُ العارف بشؤون الحرب عزَا الأمرَ إلى سقوط نيزكٍ قرب النجع، ثمّ عادَ فأطلق على النيزك اسمَ الشهاب، فما فهمَ الناس ماهية النيزك، ولا عرفوا كيف تكون الشُهُب. وشاعَ بينهم أنّ القمر الاصطناعيّ الذي تحدّث عنه الرئيس جمال عبد الناصر ربّما سقط في تجربة إطلاقه الأولى. لكنّ خليل الخوجة دأبَ على نفي الأمر، وعقبَ صلاة الجمعة وزّع على الناس طبعةً جديدةً من جريدة «صوت الحرب». كان يطبعها في صفحةٍ واحدةٍ باللّونين الأحمر والأسود، ويفسّر ذلك بأنّ الدولةَ ترشّد الإنفاق، فتُقلّل عدد الورق المطبوع، وتوفّر الحبرَ للأخبار العظيمة الوشيكة. والأغربُ من طباعة صحيفةٍ من صفحةٍ واحدةٍ هو إصرارُ الخوجة على أن يوزّعها ولدُه الأخرس حكيم على كلّ الدور في النجع، مع علمه بأنّ الغالبيّة العظمى من الأهالي لا يعرفون القراءة. لكنّه ظلّ حريصًا على أن يُطلِع الناسَ على صور الطائرات والدبّابات والصواريخ أوّلًا بأوّل.
تحدّثت صفحة «صوت الحرب» عن سقوط النيزك قرب نجع المناسي، وعادت ووصفته بالشهاب. لكنّ خبراء علوم الفضاء والقادة العسكريّين الذين صرّحوا للصحيفة، اتّفقوا على وجوب التعامل مع الأمر كأنْ لم يكن، فالوطنُ في حالة حربٍ لا تهدأ طبولُها منذ عشر سنوات، وليسَ من مصلحة الوطن أن تُنشر الأكاذيب. سعدَ الناس بذكر اسم نجع المناسي في جريدة الدولة، لكنّ سعادتهم سرعان ما تلاشت. وظَلَّ الشيخ أيّوب، الخبير بشؤون الدنيا، وابن الشيخ جعفر، وليّ الله العائد من الموت، يستشعر الخطر، وينسج له صورًا في مُخيّلةٍ أربكها ضوء الشهاب فلم تعد بمثل صفائها الأوّل.
تشكّلت للخوف في كوابيس صحوته ملامحُ قطٍّ أسود، يتسحّب برويّةٍ من حقل البرسيم المتاخم للمسجد، حتّى ينقضَّ على مرقده قُبيل صلاة الفجر بلحظات. كان يرى القطَّ يقف على ساقَيه الخلفيّتَين، ثمّ يراه ضخمًا كضواري الغاب، ينقضُّ عليه، وينتزع كبدَه، قبل أن يأكله في هدوءٍ وتلذّذٍ أمام عينيه.
راح شكُّه يتعاظم تجاه كلّ شيء، ويتساءل عن ذلك الإله الذي خلق نجعًا منزويًا كنجعهم هذا، ثمّ أسلمَ مفاتيحَ السماء ومصائرَ العباد إلى رجلٍ مجهولِ الأصل مثل خليل الخوجة، واصطفاه ليحلّ محلّه، كنبيٍّ بعثَه في قومٍ نسيهم ببُقعةٍ ممحوّة من السجلّات.
ويحتدُّ في صدره السؤال: ماذا رأى الله في ذلك النبت الشيطانيّ كي ييسّرَ له قيادةَ النجع بمباركة الدولة؟! يتساءل ويثور ويناطح السماءَ كفرًا بما أتتْ به، ثمّ يعود ويعتكف في جلسات استغفارٍ لا يقاطعها سوى نشيجه الصامت.
ويهدأ، فيعودُ ويُسِرُّ إلى نفسه بالاستفهام ذاته: كيف يضع الله ثقتَه في رجلٍ كالخوجة، جاءَ إلى النجع فارًّا من أمرٍ غير معلوم؟ قيل في البدء إنّ وراءه ثأرًا في الأُقْصُر دفعَه إلى سكنى النجوع، وقيل إنّه لصٌّ فرّ بأموال الناس، أو شرّيرٌ استحوذَ على تركة أبيه وسرق إخوته. ثمّ أخذت صورتُه تتحسّن تدريجيًّا، فشاعَ بين الناس أنّ دارَه سقطت، فضرَب في الصحراء حتّى استقرّ به المقام في النجع، وذاع بينهم الخبرُ تلو الخبر، بما يمنح الخوجة أصلًا طيّبًا وأبوَين صالحين.
يتذكّر يومَ أفاق النجع على صراخ الخوجة، وقد اكتشف أنّ تمثال الزعيم عبد الناصر -الذي انتصب ذات يومٍ في باحة داره بينما الناس نيام- قد انشطر نصفَين. يسترجع أمارات الهلع على وجوه الجميع، وقد جاؤوا يواسُون الخوجة في التمثال. بدا الخوجة ثائرًا دامعًا، والناس مطرقُون في خشيةٍ ومذلّة، وأصابعُ الاتّهام تتنقّل بين الوقوف والجلوس، حتّى أنهى هوَ الأمرَ حين حمل رأس التمثال وكتفَه اليمنى ذات الذراع المرفوعة، ووضعه في صدر داره، بينما بقي نصفُه السفليّ في موضعه؛ صنمًا بلا هيبة، ومحطّةَ انتظارٍ للطيور المتعبة.
وُضع التمثال أوّل مرّةٍ تحت ستر اللّيل، فلمّا أصبحَ الناس وجدُوه على مقربةٍ من دكّان الخوجة، تلك البقعة السحريّة التي يحجّ إليها أهلُ النجع ويطوفون حولَها يوميًّا. ظنّ بعضُهم أنّه أحد تماثيل الفراعين، لكنّ بعض الأذكياء لاحظوا أنّ التمثال لرجلٍ يرتدي حُلّةً رسميّة، ويرفع يمناه ليُحيّي جماهيرَ لا يراها سواه، ولا يسمع أصداء هتافاتها غيره.
قال الخوجة إنّ التمثال للزعيم المُلهم، وإنّه منحوتٌ في القاهرة، ثمّ أفادَ أنّ صانعيه مصابُو حرب. فتعجّب بعضُ السامعين من تفرّغ المُصابين لنحت التماثيل لمن زجَّ بهم في الحرب، لكنّهم واصلوا دفعَ ربع إيراداتهم للمجهود الحربيّ كما جرت العادة، بل طالبَ أغلبُهم بتوفير الخامات والتدريب اللّازمَين لنحت تمثالٍ أكبر حجمًا في النجع، وسمّى آخرون التمثالَ بمسخوط الزعيم، قبل أن تسري بين الناس حكاياتٌ بطلُها تمثالٌ للزعيم مبتورُ الرأس ينشط بعد مغيب الشمس، فيغادر موضعَه ليجوب الطرقات كأنّه يتفقّد أحوالَ رعيّته!
كانت المشاهدُ تتكاثف في عيني الشيخ، فتُضبّب رؤيته إلى الواقع، وفي صدره تتردّد أصداء السؤال؛ كيف نسي الناس حكاية زوجة الخوجة، فقد هربت من داره ذات عشيّةٍ تاركةً وصمةَ عارٍ على بابه؟ كيف يتناسون السهام التي ظلَّتْ مصوّبة شطر المرأة التي أنجبت صبيًّا لا يشبه أباه ولا يحمل من ملامحها قبسًا واحدًا؟ وعلامَ يُجلّه الناس ويُكرّمه الله بعد الفضيحة والشكوك والمذلّة؟ كيف يقدّسون حجَرَه المشطور ويتغاضون عن ولده المبتور اللسان وقد تزامنت ذكرى مولده مع صدمة الهزيمة الزائفة؟ أينسى هؤلاء أنّ الخوجة وامرأتَه كانَا يجهّزان الولائمَ للاحتفال بخامس عيد ميلادٍ لابنهما وقتَ نشوب الحرب؟ أَوَ ليست تلك بدعةً صرَفَ الشيخ سنواتٍ من عمره في تفسيرها؟ لماذا يتجاهلون كلّ الشكوك المتراكمة على باب الخوجة فينصاعون لإرادته ويمنحونه -صاغرين- مفاتيحَ ألبابهم؟! كيف يتبوّأ المنابرَ في الطرقات، وتتهافتُ عليه الأنظارُ تستجديه الأخبار، وترجوه كي يبوحَ بما هو مسكوت عنه، حتّى بعد سقوط الشهاب، وتبدُّل أحوال العباد؟
لِمَاذا يلتفّون حول الخوجة؟ بينما يكتفي، هو الشيخ ابن وليّ الله، بالوقوف بين الناس، ليهزّ رأسه، ويومئ إيجابًا، ويتمتم بكلماتٍ تدور في أفلاك الرضا والتسويف وجَبْر ما انكسر من خواطر الآملين.
– متى تنتهي الحرب يا شيخنا؟
«قريبًا بمشيئة الله».
– متى يعود الشباب؟
«وقتما تنتهي الحرب».
– ولماذا لا يرجعون في إجازة؟ الأمّهات بِتْنَ كالثكالى وأبناؤهنّ أحياء يقاتلون…
«الوطن كأمّ، ونداؤه أكثر قداسةً من دموع البشر».
– أفلا يستجيب الله لدعائك وصلواتنا؟
«يستجيب لما فيه الصالح لكنّكم لا تعلمون، ولو أطلعكم على الغيب لرضيتم بما أنتم فيه تتجادلون».
– الخوجة يقول إنّ الإجازات متوقّفةٌ لضراوة الاقتتال، وتقول أنت إنّ الحرب موشكةٌ على النهاية، فمَن منكما يصدقنا القول؟
هو يكره خليل الخوجة! يضايقه أن يستحوذَ الرجلُ على ما يستحقُّه هو من اهتمامٍ يليق برجل دين. هو إمام مسجد النجع الوحيد، وآخر نسل المنايسة الآيل إلى الانقراض. إنّه ابن الشيخ الذي عادَ من الموت بعد دفنه. وهو الوريثُ الوحيد للرجل صاحب الكرامات والمعجزات. ثمّ إنّه مَن وَأَدَ كلّ التوتّرات طيلةَ الوقت. هو كاتم الصوت الذي دأبَ على امتصاص التذمّر في مهده، وهو وحدَه مَن صبغ الحربَ الضروس بإطارٍ دينيٍّ يروّض آذانَ المتسائلين بعباراتٍ عن القداسة والجنّة ونصر الله القريب. هو من يربط على قلوب الملتاعين الباحثين عن مصائر أبنائهم، ما بين مُجنَّدٍ لم يعد في إجازةٍ منذ سنوات، ومُتطوّعٍ انقطعت أخبارُه ولم تنقطع الأظرف الماليّة التي يرسلها إلى ذويه. هو الساتر الحقيقيّ أمام الغاضبين، وهو حامي الدولة ومُشرّع الحرب، فلماذا يكون الخوجة مُمَثِّلَ النجع أمام الدولة؟ ماذا فعل خليل الخوجة سوى المشاركة في مظاهراتِ رفض التنحّي؟ كيف أمسَى رجلَ النجع الأوّل، وهو الضيف الثقيل المجهول النسب؟
يودُّ لو يُلقي بالخوجة خارج أسوار النجع، لكنّ الخوف ممّا طرأ على النجع يُكبّله، ووباء القلق يجرّده من إرادة المواجهة.
وكانت لشكوك الشيخ أمارات، ولمخاوفه دلالات، إذ استفاق النجعُ الهادئ عقبَ ليلة الضوء الباهر وقد استوطن أجسادَ ساكنيه الوباءُ الملعون. حاول الشيخُ أن يُعرضَ عن الأمر رغم تناميه. وظَلّ يهرب من هواجسَ لا تتوقّفُ عن استنفار حواسّه، لكنّه ترك أوهامَه وعادَ ليُقرّ بما هو جليٌّ بَيّن.
بدا الأمر كلُّه أشبهَ بخرافةٍ تسرّبت من إحدى حكايات الجدّات. كان يشعر بنفسه طفلًا مغمض العينين، تركه رفاقُه لصيقًا بحائط الدار الطينيّ وقد ولّى العالمَ ظهرَه، وراح يعدّ الأرقامَ حتّى يختبئ كلٌّ منهم بعيدًا عن ناظريه، ثمّ تركوه طيلة أيّامٍ تناوب عليه فيها اللّيل والنهار، جاعلينَ منه فريسةً معصوبة العينين، تنهشه كلّ ظلال الخوف الراسخة من حكايات الطفولة، ولم ينطق أيٌّ منهم بكلمة الخلاص؛ خلاويص![3] لكنّ توالي المشاهدات برهَن على أنّ الأمر ليس حلمًا، وقضى ثقلُ الزمن بأنّ اللّعبة التي يتصوّرها لم تبدأ حتّى تنتهي.
لقد تجسّدَ القلقُ كوحشٍ يطوفُ بنعومةٍ فوقَ أسطح دور النجع، كأنّه خرجَ من الحَجَر المضيء الذي سقط من فوهة العدم ليغيّر مجرى الحياة. فما عاد الأطفال يلعبون حذوَ ضفّتَي الترعة، وتوقّف الأهالي عن إرسالهم إلى الكُتّاب الوحيد. وأضحت النسوة صموتاتٍ كالربابة المبتورة الأوتار في دار شواهي، وما عدنَ يتغنّين وهنّ يغسلن أوانيهنّ أو يجدلن سعفَ النخل. ولا عُدن يتبسّمن بدلالٍ للأطفال المتحلّقين حول شواليّ اللبن[4] قبل غليه، ولا يمسّدنَ بِرَامَ الفخّار بكفوفٍ تلطّخها القشدة. وحتّى الجدّاتُ انزوينَ في أسرّتهنّ النحاسيّة، وأشعلنَ الشموعَ ورُحن ينطفئن كذبالة النار.
قلّ عددُ المصلّين في صلاة الفجر، وربّما في كلّ الصلوات. وكان الشيخ يتلو الفاتحةَ في صلاة الجمعة، وينتظر أن يسمعَ كلمةَ آمين تهزّ جدران المسجد، لكنّ الهمهمات الشاردة أضحت أقصى ما يبلغ مسمعه.
ثمّ ظهرت أعراضُ سقوط شعر الرأس والحاجبين.
وهكذا استيقظَ الشيخ ليجد رؤوسَ الناس وقد غدَتْ أشبه برؤوس السلاحف. حتّى النساءُ رُحنَ يغطّين رؤوسهنّ بعدما كُنَّ يتنافسنَ في قياس أطوال شعورهنّ وجودةِ جَدل ضفائرهنّ، فقد حوّل الوباء الغامض مسابقاتهنّ مرويّاتٍ حزينةً تُحكى أمام المرايا وقصصًا عن ذكرياتٍ لا تُروى، وعن ضفائرَ تُركت ليعيث فيها القمل.
أمّا الرجال، فقد حرصَ كلٌّ منهم على أن يعتمر طاقيّتَه طوالَ الوقت، بعدما اعتادوا استخدامَها في مواسم الجَني المتزامنة مع قيظ الشمس فحسب. أفلحَ الأغلبيّة في مواراة رؤوسٍ يغزوها الصلعُ بسرعةٍ فائقة، لكنّهم استسلموا لواقع الحياة بلا حاجبَين!
وشيئًا فشيئًا، بدَا على الناس ارتضاءُ العيش برؤوس السلاحف. فأصبحَ أقلُّ ضوءٍ يزعجهم، وأبسطُ صوتٍ يوتّرهم. لقد أخذوا من السلاحف مظهرَها، وخمولَها، لكنّهم لم يحظوا بما تحظى به من حمايةٍ وخصوصيّة. وبمرور الوقت، عاثَ في عقولهم وباءُ القلق.
راح الشيخُ يُراقب الفلّاحين وهم يضربون بفؤوسهم الأرضَ في همّةٍ مبتورة، وعيونُهم محمرّةٌ مفتوحةٌ على أفقٍ لا يأتي بشهبٍ جديدة. التوتّر يدمغ وجوهًا سوّدتْها الشمس، والمقلُ زائغةٌ تستقرّ بعيدًا عن مواضع ضربات الفؤوس، رؤوسٌ مُطرقة، وأجسادٌ انكفأت على ظلالها، وكفوفٌ مرتجفةٌ التحمت بالفؤوس حتّى تشقّقت. الناسُ لا يكادون يتبادلون التحايا وقد فرغت جُعَبُهم من الحكايات اليوميّة. انفضّت مجالس السمر، وطُويتْ ليالٍ يُمضَغ فيها التبغُ ويسبحُ فيها الأفيون في أفواه السهارى.
والشيخ أيّوب يضايقه أن يبقى حكيم -ابن الخوجة المقصوص اللسان- وحدَه في حالةٍ طبيعيّة. فقد ظَلّ ذلك الصبيّ وحدَه قادرًا على إبداء الدهشة، إلّا أنّه مع ذلك لم يكن يضحك! بقي كعهده نادرَ التبسّم، يواظب على الاستماع إلى أسطوانات عبد الحليم حافظ مستخدمًا جهاز جرامافون أحضره أبوه بعد نصر 67، ودأبَ على استخدامه في إذاعة أغنياتٍ تُمجّد الحرب والنصر والثورة.
الجميع ملجمون بصمت الرهبة، والبعضُ غائبٌ منذ تلك اللّيلة، كأنّ الانفجار نالَ منهم فتبخّروا كما روى خليل الخوجة عن تبخّر الناس في اليابان عقبَ قصفهم بالنووي. سرت أنباء عن نزوحٍ جماعيٍّ لبعض الناس ونجاحِ بعضهم في التسلّل وكسر الحصار المفروض على النجع. لكنّ الخوجة كذّب الأخبارَ بثقةِ العارفين، وراهنَ على أنّ الناس سيعتادون الغياب. وقد شملتْ قائمة الغائبين منذ الانفجار شواهي؛ سيّدة النجع الغنجة، وهي امرأةٌ يرغب في مرضاتها كلُّ الرّجال، ويطوفُون حولَ جلبابها الضيّق، لفتنتها، ودرايتها بتحضير العرق. واختفت كذلك الخالةُ وداد قابِلة النجع الوحيدة. وهاتان المرأتان -على وجه الخصوص- ظلّتَا عصيّتَين على النسيان.
– أفضل ما فعلَه الحجر الساقط من السماء أن سحق تلك الفاجرة السافرة الوجه والجسد…
تقول زوجتُه الأولى متشفّيةً، فيومئُ في خنوعٍ. وكذا تفعل زوجتُه الثالثة، وهي أكثرهنّ شبابًا وأقلهنّ غيرة. فيحار الشيخ في تفسير كراهية النساء كلّهنّ لشواهي، وتنفلت منه بضع كلماتٍ أودعها أمانيه:
– لا أحد يعلم مصيرها، والله أدرى بأفئدة العباد…
– أفلا يعرف الشيخ الفارقَ بين مؤمنةٍ وفاجرةٍ كشواهي؟ أم هو مفتونٌ برقصها ككلّ رجال النجع؟
تحاصره الزوجة الأولى بعلامات استفهامٍ طالما جاهدَ لطردها من رأسه، وتتواصل إيماءاتُه بين النفي والإيجاب، وتتعالى همهمات زوجتَين تطوّقهما نظراتُ زوجةٍ وسطى تعتنق الصمتَ ميثاقًا منذ زيجته الثالثة. فيُؤْثِر الشيخُ الفرارَ من زوجاته الصلعاوات حتّى يبلغ عتبة الدار فيطلق كلَّ زفرات القلق المؤجّلة، ويهيم في التفكير…
تبخّرت شواهي. اختفتْ كأنّها لم تكن أكثر من قصّةٍ تتنقّل بين شفاه الجدّات الغارقات في نوبات الحنين إلى أيّام الترحال. أُغلقتْ حانتُها، وكان الشيخُ جعفر الوليُّ قد حدّد موضعَها، فأشار بأن تكون بعيدًا عن حدود النجع الرسميّة، خارجَ صفّ النخيل الذي يُحدّد آخره شرق الترعة، لكن على مقربة من أهل النجع. وبذلك أنهى صراعًا دارَ بين فريقَين من الناس شقَّ وحدتهم، بين مُحبٍّ للّهو، ورافضٍ للمحرّمات.
يُسِرّ الشيخ أيّوب لنفسه أنّ الحياة نقصتْ باختفاء شواهي، ولعلّ لغيابها أثرًا في انتشار الحزن على الوجوه. الحياة تتداعى، وهو ينسحب رويدًا رويدًا، ليغوص في سردابٍ طويلٍ ينأى به عن نفسه التي يألفها.
وتمرُّ الأصباح والأماسي، فتتمدّد خيمةُ الغربة وتحطُّ على رأس الشيخ لتحاصر أنفاسَه وأفكارَه. حتّى عمامتُه المهيبة لا تُنسيه حقيقةَ أنّ ما تبقّى من شعر رأسه يكاد يُحصى بسهولةٍ أمام أصغر مرآةٍ في النجع. يحدّث نفسه، يلوم الأقدار إذ لم تمنحه صبيًّا يمتدّ بحضوره سلسال المنايسة ويتعضّد اليوم به، ويلعن زوجاته الثلاث اللّاتي دأبتْ أرحامهنّ على إنبات الإناث. ظلّـت غايتُه أن يهبه الله غلامًا يُسمّيه جعفرًا تيمُّنًا بأبيه الوليّ، لكنّ الله لم يمنحه الولد، بل منحه خمس صبايا، ثمّ منح الصبيّ المرجوّ لخليل الخوجة!
راح يتصوّر أسوأ المصائر للنجع، ويستدعي من حكايات الأسلاف حكايةَ النجع القديم إذ دهمَه السيلُ فأغرق أغلبَ ساكنيه. كان جدودُ ساكني النجع الحاليّ الناجين الوحيدين من مأساة النجع القديم خلف الجبّانة، وها هم يشهدون مصيرًا مشابهًا. آمنَ أنّ النجع باتَ بقعةَ ابتلاءٍ أزليٍّ اختصّها الله بالخوف والمرض. ولاحظ أنّه باتَ يُكثر من التلفُّت حوله في الطرق المظلمة، فيُفزعه أوهنُ صوتٍ لصرصورِ حقلٍ بعيد، ويوقظه من نوبات نومه المتقطّع مواءُ قطّةٍ جائعةٍ. وشبح القطّ الأسود يُطارده. يحكُّ الشيخ موضعَ حاجبَيه الزائلين حتّى يحمرّ منبتُهما، ويطوف بين الديار كالمجذوب يبحث عن قابلة النجع وداد، ويطرقُ بابَ دارها الموصد حتّى يكاد يخلعه؛ فامرأةُ النجّار توشك على وضع جنينٍ يدحر الحكايات عن عقمها. أمّا نوح النحّال، فقد بلغَ به القلق أن هجر منحل أبيه بعدما انعزلَ فيه سنوات، وراحَ يتمتم لنفسه، وهو يجول بين الأزقّة مخمورًا، أنّه ترك المنحل للنحل، لأنّه لم ينتمِ يومًا إليه، ثمّ إنّه يثق بأنّ النحل سيثور عليه إن تجرّأ على العودة قبل أن يعود ولده الذي أخذوه إلى الحرب.
اعتادَ الناس مشاهدةَ نوح مترنّحًا في أغلب الأماسي، يسبُّ الحرب والخوجة، ويسبُّ كلَّ أهل النجع لتخاذلهم حيالَ استرجاع وحيده من الحرب، ويتّهم النحل بخيانته!
تؤرّق الشيخَ حقيقةُ أنّ العجوز وداد، وهي قابلةٌ التقطت كلَّ مواليد النجع من أرحام أمّهاتهم، وتقطن غرب الترعة، قد اختفت. وشاعَ بين الناس أنّها آثرت أن تقبع في دارها وتعزفَ عن مجالس السمر، منفردةً بالجوزة وعلبة النشوق[5]، فقد خشيت مزاولةَ عملها الذي لم تعرف غيره، متذرّعةً بسيلٍ من كوابيس يهاجمها ويُبشّرُ بموت كلّ رضيعٍ يحطُّ بين كفّيها. بيد أنّ كلّ تلك الأخبار المربكة جعلَتْ تتواتر بلا قرينة.
والشيخ يغزوه الرعبُ كلَّ يوم، يراجع تعداد النجع، يعدُّ في رأسه سبعين دارًا يحفظ ساكنيها. الجميع مُبتلُون، واللعنة نالت منهم كلّهم إلّا ابن الخوجة. وعنايات زوجةُ محجوب النجّار قد تلد قبل انقضاء الشهرين الأخيرين من حملها، ولا أحد يقدر على تولّي أمرٍ كهذا سوى العجوز وداد، والسيّارة الوحيدة في النجع أعلن صاحبُها خليل الخوجة أنّها معطوبةٌ منذ سنوات. فأين المفرّ؟
ذات يومٍ انفلقت السماء عن صباحٍ ضبابيّ، وجدَ فيه الناسُ عبارات وعيدٍ وتهديداتٍ بالموت وإهاناتٍ وتنبّؤاتٍ سوداء كُتبتْ بطلاءٍ أسود على جدران البيوت. وكان بيت نوح النحّال أوّلَ ما لطّخت العباراتُ جدرانه. فثار، وأوشك على فقدان ما بقي من عقله، ويبدو أنّه أفرطَ في شرب الخمر، فراح يتّهم الناسَ بتلك الفعلة. ولم يخصّ متّهَمًا بعينه، بل أطلق وابلًا من اتّهامات عشوائيّةٍ للجميع، وفي مقدّمتهم خليل الخوجة.
تلا ذلك تداولُ أخبارٍ عن ظهور عباراتٍ أخرى مشابهةٍ على بيت شواهي الخاوي وبيت النجّار البعيد. ثمّ راحت الكلمات المغمّسة بالكراهية تتناسل على جدران كلّ البيوت. كلّ ساعةٍ يكتشف واحدٌ من الناس بعضَ العبارات؛ بعضها كُتب على صدر الدار، وبعضها خُطّ على حوائط جانبيّةٍ أو خلفيّة. وهكذا أصبحت كلّ الدور موصومةً بالطّلاء الأسود ذاته، مُعنوَنةً بكلمات اللّعنة والتشفّي، بما فيها بيت خليل الخوجة، ودكّانه، والتمثال المكسور حذوَ داره، بل على جدران المسجد أيضًا.
تعاظم ماردُ القلق على الرغم من جهل الغالبيّة بالقراءة، لكنّ العارفين منهم تطوّعوا لفكّ شفرة ما كُتِب على الجدران. أُقفل كلّ بابٍ على ساكنيه، ومَنعَ الأهالي الصغارَ من مغادرة الدور، وراحت النساء يتبادلنَ نظرات العداوة، وحَدّدت كلٌّ منهنّ لنفسها مساحةً من ترعة النجع لا تشاركها فيها جارة، ولا يسبح فيها طيرٌ من غير طيورها. بينما راح الرجال يسعون بين حقولهم وورشهم، وقد تسلّح كلٌّ منهم بما يحميه من ذلك الآخر الذي لا يعرفه، لكنّه يثق بأنّه قريب.
والشيخ يُحدّث نفسه في الطرقات. ينتظر أن يسمع كلمةَ «خلاويص»، لكنّها تستمرّ في الغياب. فكان يطرق أبوابَ الجيران بحثًا عن وداد القابلة وقد اشتدّ صراخ عنايات قبل أوان ولادتها. قد يدفع الخوفُ الجنينَ قبل موعده، بل إنّ الهلع ذاته قد يجبر عنايات على اعتصاره في رحمها حتّى تنجّيه من الظرف الراهن. لا يفتح أحدٌ بابَه لزائر. والشيخ العجوز، الذي وهب عمره للوصل بين الله وعباده، يبكي، يشعر بعجزٍ يُثقل خطواته وقد فرغت جعبتُه من التفاسير، وغابت عن لسانه الفصيح سُبل الإقناع. بقيت لديه بضع نتفٍ مقتطعةٍ من شروحٍ لآياتٍ عن غضب الخالق على المخلوق، وقصص قوم عاد وثمود، وفرضيّات عن السحر، وعمل الجنّ المذكور في الكُتب المقدّسة. لكن لا حلول.
أجلّه أغلب أهل النجع، ربّما لم يُلبسوه ما خصّوا به الخوجة من رداء المهابة، لكنّهم كانوا يضعونه هو أيضًا في مرتبةٍ أسمى من عموم الناس. وذلك ما وَضَع على عاتقه مسؤوليّةَ إيجاد الحلول والتفاسير. الجميع يتحرّون الحقيقةَ في عينَيه بعدما أسبغوا عليه قداسةً ورّثوه إيّاها عن أبيه، لكنّه كان يراوغ الأبصارَ بعينَين زائغتين ولا يدرك كيف تُصنَع المعجزات.
ومرَّ محجوب النجّار بدار الشيخ أيّوب. زاره وهو يدفع أمامَه عربةً صفيحيّةً فيها صندوقٌ مملوءٌ بعلب الغراء وورق النشارة والمسامير، وكمّاشةٌ قديمةٌ استعمرها الصدأ، علاوةً على ثلاثِ فؤوسٍ جديدةٍ وجاروفٍ ضخم. ظلّ محجوب صامتًا دقائقَ طالت، وكان يتلّفت مع كلّ التفاتةٍ لعنق الشيخ، يُداهم الظلامَ بعينَيه بحثًا عن السرّ المخبوء. فربّت الشيخُ على كتفه فانتفض، إذ كان توّاقًا إلى تلقّي الأسئلة والاستفسارات وإنْ جهل الإجابات. لكنّه لم يتلقَّ طوالَ الأيّام الأخيرة أسئلةً. لم يسأله أحدٌ عمّا يخصّ الدين وصحيح عقائده. انصبّت جلّ الهواجس قبل الوباء على حكايات التمثال الذي يدور بين الدور عقب المغيب يبحثُ عن رأسه المقطوع، وعن النسّاج المسكين قتيل الترعة. لكنّ الأفواه باتت اليوم مطبقة، والعيون مُشرعةً على السماء حيث أغشاها ضوؤها العظيم. سكونٌ ثقيلٌ خيّمَ على الشيخ، فباتَ يقوّض مكانةً عاش يتخيّلها، وهذا واجبه المقدَّس: أن يُسأل، وأن يجيب عن أسئلة الحيارى، وأن يئد القلقَ في صدور المتشكّكين، لا أن يظلّ نسيًا منسيًّا في مسجده.
أخيرًا تحدّث النجّار: «هل من أخبارٍ عن وِداد؟» فردّ الشيخ بعبارةٍ تغلّفها حيرة التائه: «العلم عند علّام الغيوب».
أشار محجوب إلى صندوقه وأحماله، وقالَ شاردًا إنّه اشترى بضاعتَه من دكّان خليل الخوجة. فأومأ الشيخ إيجابًا، فاستطرد النجّار يسأل:
– يا شيخي، ألا تعرف ما سبب الضوء الباهر الذي كسَا السماء وصاحَبَه دويٌّ مفزع؟
ثمّ همس بنبراتٍ مرتعشةٍ خفيضة، كأنّه لا ينتظر إجابةً شافية:
– كذلك… يا شيخي… اعذرني، ولكن… سقوطُ الشعر… الحاجبان… العباراتُ المكتوبة على الجدران… ألا يبدو الأمر عقابًا أنزله الربّ على قومٍ من العصاة؟ هل تمادينَا في ذنوبنا فنزلت علينا صاعقةُ السماء؟ هل صرنا كقوم عاد وثمود ولوط؟ أم إنّنا وُرّثنا مصيرَ أجدادنا الغرقى؟
طرب الشيخ أيّوب لسماع كلمات النجّار، وقد كاد يألف ألسنةَ الناس ملجمة. فتلفّت حولَه أكثر من مرّة، وحكّ موضع حاجبَيه، ولـمّا تأكّد من عدم وجود أحد، مالَ على النجّار هامسًا:
– كان شرٌّ خفيٌّ يقترب، وما الشهاب سوى سهمٍ أطلقه الله فأصابَ به عدوّه الذي لم يرَه سواه، لكنّ بعض أشلائه تطايرت يومذاك، ومنها ما استقرّ في قلب النجع فسبّب ما لاحظناه جميعًا. ولكن، لا تقلق، ولا تيأس من رحمة مَن فتّت الحجر ليحذّر البشر، فسهام الله لا تنفد، وقريبا تزول كلّ تلك العبارات وتنبت الشعور بزوال الشرور…
فهزّ النجّار رأسَه، وتبادلَ مع الشيخ نظرةَ اطمئنانٍ كاذبة. وتظاهرَ كلٌّ منهما بأنّ كلّ شيءٍ على ما يرام. استرجعَ محجوب كرامات الشيخ جعفر، فأضفت الذكرى قداسةً وخصوصيّةً على كلمات ولده أيّوب. تصنّع الرجلان الاقتناع بأنّ الأمور كلَّها تسير على عادتها، ثمّ انصرف محجوب يدفع أمامَه عربتَه، مُردّدًا ما فهمه من كلمات الشيخ:
– سهم الله في عدوّ الدين… سهم الله في عدوّ الدين…
[1] الطلمبة: آلة ميكانيكيّة تستخدَم لرفع المياه من مستوى إلى آخر من أجل استخدامها في ريّ الأراضي.
[2] الجبّانة: المقبرة.
[3] خلاويص: كلمةٌ ترتبط في التراث الشعبيّ بلعبة (عسكر وحراميّة) وهي لعبةٌ ارتبطت بمرحلة الطفولة، إذ يغمض أحدُ الأطفال عينيه وينتظر حتّى يختبئ باقي الأطفال، يسأل الطفل المغمض العينين «خلاويص؟» فيجيبه الأطفال «لسّه»، بمعنى أنّهم لم يحكموا اختباءهم بعد، فيواصل الطفل إغماض عينيه ويكرّر السؤال مرّةً تلو أخرى، حتّى يجيبه الصمت فيشرع في البحث عنهم، ومن يعثر عليه أوّلًا بكون هو المكلّف بإغماض عينَيه في الدورة الجديدة من اللعبة.
[4] شوالي اللين: أوانٍ فخّاريّة يترك فيها الحليب في درجة حرارة الغرفة حتّى يتجبّـن اللبن خلال ثلاثة أيّام حسب حرارة الجوّ، ثمّ تفصل طبقة القشدة المتكوّنة أعلى الحليب، ويعرف ما تبقّى أسفلها باللبن الرائب.
[5] النشوق: تبغٌ ناعمٌ مطحون جافّ، كان قديمًا يُعبّأ في علب من صفيح، ويتمّ تعاطيه عبر شمّهٍ بواسطة الأنف مباشرة، أمّا النشوق الرطب فهو ما يوضع خلف الشفة أو بين اللثة والخدّ.