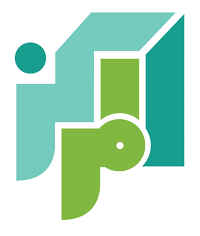بعد غياب دام 13 سنة، يتحدث الكاتب والمترجم عدي الزعبي عن زيارته الأولى للشام والجامع المعلق، وعن نهر بردى الذي اشتهرت دمشق به، في رحلة يستعيد فيها زمنًا مفقودًا.
عدي الزعبي
«مُرّ بي، يا واعداً وعدا، مثلما النسمة من بردى»، تقول فيروز. ولكن بردى لا يتجلّى كثيراً في دمشق، على العكس من أشعار البحتري وأحمد شوقي ونزار قباني، وسعيد عقل- صديق فيروز وصاحب قصيدتها هذه. انفك النهر عن المدينة، وعن عمرانها، وعن معناها. اليوم، يثير في قلوب الناس شيئاً من الشجن، كذكرى قديمة باهتة في صور بالأبيض والأسود، وعناق الجدّات، ورائحة النعناع المجفف، وحنين لأشياء غامضة مبهمة.
وصلتُ دمشق بعد غياب طويل -13 سنة- وأنا أدندن الأغنية الشهيرة، عن بردى والوعود المهدورة والسيوف والشموس والهوى الشآمي؛ والنهر ما زال يجري ويسوح، في غيابي وحضوري، وأنا ألاحقه، في محاولة هوجاء للقبض على ما لا يمكن القبض عليه: الماضي، وروح الشعر، وزمن الحرب التي انتهت.
أبدأ من الجامع المعلق. أقف على بابه الرئيس. درجان صغيران يؤديان إليه. الباب خشبي قديم، محاطٌ بأشكال هندسية مُحكمةٍ. ولكنه مغلق. أتوجّه نحو الباب الأصغر، الذي تعلوه مقرنصات ساحرة. أيضاً مغلق. الشارع مزدحم ومليء بمحلات حدادين وحرف مشابهة، شارع الملك فيصل. عملياً، يقع الشارع والمسجد خارج سور المدينة القديمة، وبيوته متهالكة، وكذلك محاله. العديد من الشوارع الفرعية تربطه بالمدينة القديمة. ألمح باباً صغيراً حديدياً، كباب بيت فقير، مكتوبٌ فوقه: «الجامع المعلّق». أدخل متردداً، لأجد الميضأة الحديثة. أخرج منها، إلى صحن الجامع.
يقوم الجامع المعلق فوق نهر بردى، على قناطر غير مرئية من هنا، في أحد أكثر الشوارع ازدحاماً اليوم، وأبعدها عن الجمال العمراني. ولكنه بُني كي يكون بعيداً ومنعزلاً عن المدارس والجوامع والقصور المنتشرة داخل السور وفي أحياء الصالحية والأكراد. يجري نهرنا تحته، كأنه يرويه، كوردةٍ لا تفنى. مع ذلك، النافورة مغلقة والبحرة جافة في الصحن، لتوحي بأن الدين، وبردى، والحرية التي حصلنا عليها مؤخراً، معلقةٌ حتى إشعار آخر. أقترب منها بحذر. تحيطها نباتات مزروعة في تنكات قديمة، كأنها في بيت عائلة كبيرة. أدور حولها، مشدوهاً بالحجارة المتتابعة على الحيطان: أسود، أبيض مصفرّ، أسود، وردي ناعم، أسود. الوردي ينعش الروح، كأن البلد المكسورة تتمسك به لتنجو. أمامي المصلى، وعلى اليمين واليسار ميضأتين فصلوهما بحواجز زجاجية عن الصحن، ببشاعة مفجعة. لا يناسب الزجاج جوامعنا العتيقة. أدخل الجامع. يتبعني شابٌ كان يراقبني. المنبر خشبي، محفورٌ بأشكال هندسية ساحرة. والمحراب رخامي حديث، بأضواء خضراء قبيحة. الترميم هنا سيء، كل شيء مدهون بالأبيض، بما فيه السقف. من النافذة، يمكن رؤية بردى يجري: جدولٌ صغير مليء بالأوساخ، بين بيوت قديمة في مدينة عتيقة ملوثة. أعود إلى الصحن، ويتبعني الشاب. فوق الباب الرئيس، على اليمين، نشروا غسيلاً، إذ يضم الجامع معهد أبي الحسن الشاذلي للعلوم الدينية.
يقترب مني. يسألني متوجساً عما أفعله هنا. لا أملك إجابة واضحة. «أبحث عن بردى»، أدمدم، لنفسي. يتضاعف شكه. أخبره باسمي، ومهنتي، وكتبي المنشورة. يبقى التوجس قائماً. يقول إنه من حماة. يدرس هنا. لا يعرف شيئاً عن تاريخ الجامع، أو عن سبب إغلاق الباب الرئيس، أو عن النافورة الجافة. أتنهد، محبطاً. الشمس مشرقة. شجرة كرمنتينا / يوسف أفندي وحيدة في الزاوية، مزهرة، فيها عدة حبّات، تلوّن دمشق، والإسلام، وروحي، بمرح. الباب الرئيس مغلق بشكل كلي، من الداخل، تتكئ عليه سجاجيد عتيقة وكراكيب كثيرة، وعدة دراجات هوائية مكسورة. أشعر بسكينة مؤقتة، وأنا أرتّل في قلبي من التنزيل الحكيم: «وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ».
أنسحب إلى الخارج. أبتعد نحو الرصيف الثاني، لأصور المئذنة المثمنة، القصيرة، العريضة. لا توجد قبة. يسخر مني شابان بجانبي بلطفٍ، لأنني أبدو كسائحٍ أجنبي يصوّر كل شيء. ندردش عن المئذنة. أغادرهما، عائداً إلى سوق المناخلية المزدحم، ثم أتبع النهر، على كتف السور القديم، بجانب القلعة، مفكراً بالجامع المملوكي الحميمي: تدين دمشق للأيوبيين والمماليك بمعظم تراثها العمراني الإسلامي. أجرجر أفكاري المتبعثرة كأغراض صحن الجامع: ما الذي يعنيه التاريخ لمستقبل البلد المتأرجح بين جهاديين سابقين يحكموننا بحنان عجيب وأغاني فيروز الدمشقية التي ما زالت تتردد في كل مكان؟ لماذا تميز العصر المملوكي بالجدايل الحجرية المدككة والأعمدة الحلزونية، كالتي يتيه بها الجامع على محيطه الفقير؟ هل ننتظر كي يُفتح الباب الكبير لندخل، أم يكفينا الباب الضيق؟
آلاف الريفيين ملأوا دمشق ببسطاتهم، يبيعون كل ما يخطر على البال. معظمهم من أرياف إدلب وحلب. مسلحان من الهيئة، يجلسان بكسل، ويراقبان. عشرات -أو مئات؟- آلاف الريفيين قدموا مع التحرير، كي يزوروا دمشق، المحرّمة عليهم قبله. الأطفال يتسلقون تمثال صلاح الدين الأيوبي، وحصانه، على مدخل القلعة، ويأخذون الصور. «يوم الحشر»، يردد شيخٌ يحاول أن يعبر إلى شارع الحجاز معي. اللطف والتهذيب يطغى. لا يوجد إلا سعادة تطفح من الوجوه. لم تتعرضّ دمشق للقصف، على العكس من الأرياف التي مسحها القصف الروسي والأسدي. لا يصدّق المرء هذه الانسيابية، في بلدٍ تعيس بدون قانون أو شرطة، بميوعة بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية. الزحمة شديدة. يتذمّر بعض الشوام من القادمين الجدد. أدخل من شارع فرعي إلى ساحة المرجة. يجري بردى تحت الأرض، قبل أن يعاود الظهور فيها. أتبعه، عاجزاً عن فهمه.
تنفتح ساحة المرجة على عمودها الشهير، «خازوق المرجة»، بحسب المقولة الشعبية. تحيطه أبنية متنوعة، من مبنى العابد الفخم، إلى بناء طلياني تدور زواياه برقة، إلى بناء حديث بشع، وجامع يلبغا، ووراءه مجمع يلبغا قيد التنفيذ. الزحمة خانقة. صرافون، وإسكافيون، بشكل رئيس. لأول مرة انتبه إلى أن رأس العمود عليه مجسم جامع، علمتُ لاحقاً أنه جامع يلدز في إسطنبول. تتزاحم صور المفقودين، التي بهت لونها، وتمزقت أطرافها، على العمود، من كل الجهات. أقترب منها بذعر. لم يمر سوى شهر على التحرير، وملامحهم تكاد تتلاشى من قلب العاصمة. المزيد من الريفيين، بعباءاتهم الفخمة، ورقتهم، وخجلهم. بعضهم مقاتلون بشعور طويلة، على سنةّ النبي، كما يقولون. الحمامات تطير. انتهى الفتح العثماني، الذي بدأت قرونه الأولى بنهضة اقتصادية مدينية كبيرة، بإعدام المناضلين السوريين المعادين للتتريك في هذه الساحة، في السادس من أيار 1916. يجري بردى بخفر وكسل وتردد، في الساحة، كأنه مجبرٌ لا مخيّر. أشجارٌ قليلة، والساحة فيها شبكة صغيرة من الممرات، فوق النهر، تملؤها البسطات. الحمامات تطير، كأنها لا تكترث. هذا ما أذكره من الساحة، من طفولتي، إلى اليوم: حمام يحوم بمتعة، وبدون سبب. تحولت فنادقها الكثيرة إلى مواخير العاهرات والقوادين، لعقود، بجانب وزارة الداخلية. زرتُ أحدها، وأنا في السادسة عشرة من عمري، زيارةً انتهت بهروبٍ كوميدي. ثم طردوهم إلى الضواحي، مع مجيء الألفية الثالثة. النخيل أشجاره غير متزنة: باسقة وقزمة، لا تكفي لزرع الأخضر في العيون. على زاوية الساحة، شجرة كينا عظيمة، تحمي الروح. واليوم، أصبحت مزيجاً من ريفيين يهبطون في فنادقها، وعائلات مفقودين في سجون الأسدين، يتجمعون فيها بأسى مطالبين بحقائق قد لا تبين.
أتبع بردى. يسري تحت الأرض، قبل أن يعاود الظهور بعد جسر الثورة. حصانان يعبران، مذعوران من كل شيء. شابٌ يلبس كنزة حمراء كتلك التي يلبسها الغربيون في عيد الميلاد. على اليمين، فندق «الفور سيزنز»، فندق الفاسدين في النظام، واللقاءات الأمنية للإدارة الجديدة. بشاعته تغطي المدينة، وتكشفها. أتجاوزه، وأحث الخطى، بعزيمة مشدوهة. أمشي بجانب النهر. هنا يتسع مسراه. الأوساخ تتراكم، كساقية قذرة في بلدة مهملة. المزيد من البسطات. شحاذون بالمئات. المرة الأخيرة التي فاض بها كانت عام 1988. كنتُ في السابعة من عمري، وأُغلقت المدارس. كان ربيعاً بارداً؛ وبردى يتدفق في الربيع، لا الشتاء. أسأل فتاة شحاذة عن اسمها، ومن أين أتت. تنظر إلي بقرف، ولا تردّ. تتنهد. أعطيها ألف ليرة (أقل من عشرة سنت). تبتسم بتصنّع، وتضعها في جيبها، بملل.
أدخل المتحف الوطني، المطل على النهر. على الباب، يقف الإله حدد/بعل، بتمثال مكتمل لم يتعرض للتلف، بحجمٍ أكبر قليلاً من حجم البشر، ولكن بدون معلومات عنه. طاقيته الشهيرة تميزه، وعيونه الجاحظة. أول يوم يعود إلى العمل، منذ التحرير. الموظفون مرتبكون تماماً. المقهى الصغير فيه شبابٌ يتكلمون بصوت عال. أجلس، وأستمع إلى مجموعة من طلاب الآثار يناقشون مستقبل البلد: دولة مدنية أم إسلامية أم علمانية، الأصنام والتماثيل، ترميم الآثار. حيوية معدية، ولكن ليس لي. أدخل المتحف، غير واثق من خطواتي. البوابة مأخوذة من قصر الحيرة، أحد القصور الأموية الشهيرة. ألجُ العصور الكلاسيكية. تبدأ مع وصول الإسكندر المقدوني، يتبعها تفكك إمبراطوريته، وسوريا من حصة السلوقيين، مجيء الرومان، وإمبراطوريتهم العظيمة الأرستقراطية، ثم تحولها إلى المسيحية، والعهد البيزنطي. تعكس التماثيل تخبطاً في معنى الفن: بعضها يحافظ على شيء من البلادة والخشونة والجلافة والفخامة الآرامية، على العكس من الحركة الانسيابية اليونانية والرومانية. بعضها يشكل مزيجاً. لا أحب اليونان والرومان، لا أحب تمثيل الكمال الإلهي في الأجساد البشرية. أفضّل شيئاً آخر. تمثال لامرأة عادية، من شمال سورية، أمام لوحات الفسيفساء الثلاثة. لا يجسد الكمال، بل البشري اليومي. أقف أمامه، كأنني وحدتُ ضالتي في الكون: المزيج الأفضل لجلافة التراث الآرامي المحلي مع الانسيابية اليونانية، بدون مثالية الآلهة. لوحة الفسيفساء على الأرض تصور طاووسين، وطيوراً أخرى، ونباتات، وصليباً صغيراً، بدون بشر. الزوار قلائل. طلاب تاريخ أو آثار. وقادمون من الأرياف، يرون متحفاً للمرة الأولى. سعادتهم طاغية، وسعادتي معهم. ينقذونني من تأملات لا تصل إلى نتيجة، عن أغرب فترة في تاريخ سوريا: ما أطلق عليه الغربيون الفترة الكلاسيكية، حين أصبحت سوريا جزءاً من إمبراطوريات اختلطت بها تماماً، وبقيت متمايزة عنها، في نفس الوقت. صبية في بداية العشرينيات، تريد التقاط صورٍ في المقبرة التدمرية. تشبه الرسمَ النافر لصبية تضع حجاباً في المقبرة، بل تكادان تتطابقان. زوجها يتذمر، كما أتذمر أنا باستمرار من الصور؛ ولكنه يرضخ، في النهاية. أخرج من المقبرة، وروحي ترفرف بالرغبة بحياة مختلفة جادة عذبةٍ قريبة.
كل الأقسام الأخرى مغلقة، منذ أيام النظام البائد: عصور ما قبل التاريخ، والعصور القديمة (قبل الكلاسيكية)، والعصور الإسلامية، وحتى العصور الحديثة. لم يبق إلا الخليط الكلاسيكي المزعج العجيب الساحر. أخرج محبطاً. أدور في الحديقة، التي تحوي آثاراً متناثرة من كل العصور. البحرة الصغيرة جافة. أشجار الكرمنتينا مثمرة. الحديقة ممتلئة بالعشاق، اثنين اثنين: طلاب يدخنون، صبايا سافرات مع شباب «كول» بشعور طويلة، محجبات متحشمات مع فتيان خفورين. أمشي بينهم، خجلاً من وحدتي. آثار ملقاة بلا ترتيب، مسيحية، وإسلامية، وآرامية، ورومانية، ويونانية: كل أنواع الحضارات، تحيط بالعشاق المساكين، الهاربين من الحرب، والتحرير، والحرية، في حديقة معزولةٍ لبقة، ضمن أحد أكثر الشوارع ازدحاماً في سوريا كلها. أتركهم، وأودع حدد: الإله السوري بامتياز، إله المطر والعواصف، يقف بشموخ، يحرس المتحف، والعشاق، والحديقة.
أتوجّه نحو مقاهي الربوة، التي تقع على طرف المدينة. سائق التاكسي يستمع إلى نانسي عجرم: «حبك سفاح، مجرم وشايلّي سلاح». لا تتناسب الكلمات مع اللحن الراقص المسلّي. تطل كل المقاهي على النهر، وتتنوع كثيراً: من مطاعم فخمة، إلى مقاه شعبية. أمضيت معظم أمسيات سنوات المراهقة وبدايات الشباب في تلك المقاهي. لم يتغير شيء. عاملون في مطاعم رخيصة، يرحبون بي بود، ويضحكون علي علناً: أبدو لهم كخبير أجنبي، بأسئلتي عما تغير، عن الحرب، عن بشار، عن التحرير ومشاعرهم. توجهت إلى تلك التي أعرفها جيداً: «الشعّار»، و«العجلوني». ولكن كل شيء على حاله هنا، سكة الحديد التي لا تجري عليها أي قطارات منذ الستينيات، الكراسي البلاستيك البيضاء، أم كلثوم تتذمر بخفّةٍ خشنة: «تفيد بإيه يا ندم، وتعمل إيه يا عتاب!»، الوجوه المتعبة، المشاجرات حول لعب الورق، الأبواب الزجاجية محطمة الاطراف مغطاة بورق الجرائد، مصابيح تئزّ هنا وهناك، الشاي «الخمير» الصدوق يدفئ القلوب المرتجفة. قد لا يصدّق المرء أن الحرب مرت من هنا، أو الزمن، أو غياب المعنى، أو الشيطان الخنّاس يوسوس لأولئك الرجال الذكوريين مدّعي الشجاعة والرجولة، طيبي القلب، يهربون من كل شيء، من أجل ساعات قليلة في مقاه لم تدخلها امرأة قط.
بردى يجري هنا، بانسيابية، وبزخمٍ أكبر من المدينة، رغم صغر حجمه ومجراه. البيوت القريبة تكاد تنهار، كأن زلزالاً ضربها؛ هذا حالها منذ بدأتُ أرتاد المكان في منتصف التسعينيات. ولكنها صمدت، وبقيت حية، حيوية، حامضة. وبردى يسلّيها، يحدثها بخرير طري- ربما، عن الزمن. الكهرباء مقطوعة. صوت مولدة الكهرباء ورائحة المازوت تقتلان أي رومانسية مفترضة؛ لا يشبه هذ المكان القصائد العصماء. ولكن مقدمة «مر بي» أقل وثوقية، وأكثر هشاشة، من عجرفة الفخر الوطني المعتادة؛ يصفّيها اللحن العبقري لمحمد عبد الوهاب، اللحن المصري الذي ألفه كرمى لبردى الشجي؛ له أترك نفسي تفلت منّي، فرحاً بعودتي، المؤقتة، إلى مدينتي: «مرّ بي، يا واعداً وعدا، مثلما النسمة من بردى، تحمل العمر، تبدده!».
ثلاث عشرة سنة. نافذة مكسورة. صياح وشتائم. دخان الشيشة والسجائر. أوجاع في الكتف الأيمن لا علاج لها. صفصافة تنحني بملل. فرحٌ يكتمل بحزن، كاليانغ واليان. وفيروز تشدو، برقّة لا تناسب الكلمات، بل تناسب العودة، والغياب الذي سبقها، وما سيأتي بعدها:
«ما أطيبه بددا!».