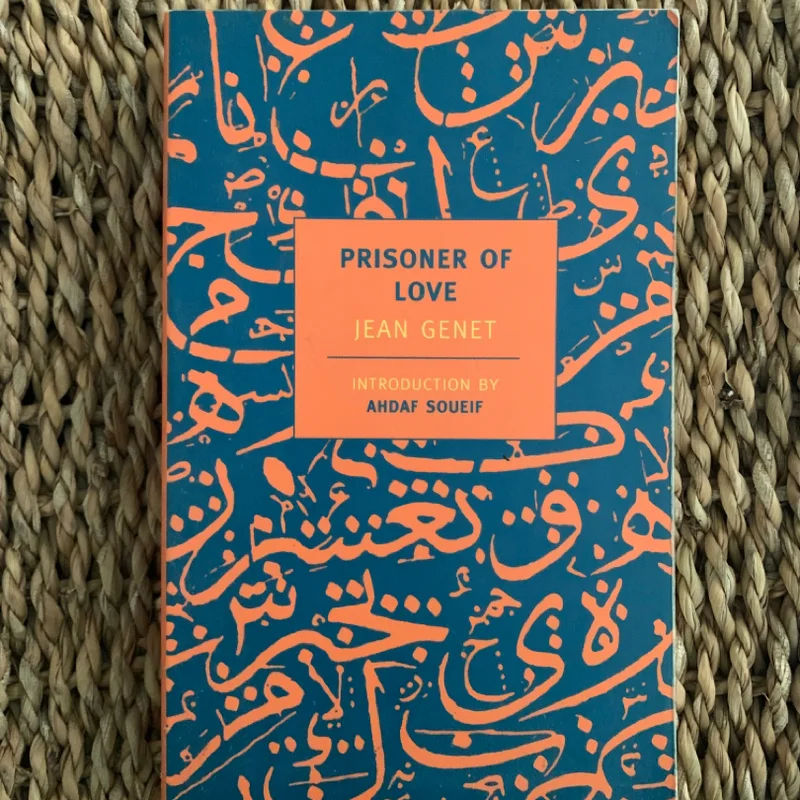أحد الموضوعات الرئيسية في سجين الحب هو استكشاف جينيه لقدرة اللغة على الوصول إلى نسخة من الحقيقة. فهو يعترف في الصفحات الأولى من الرواية بأن حقيقة الثورة الفلسطينية لن تجدها في محاولات وصفها، بما في ذلك محاولاته هو نفسه.
سليم حداد
منذ أربعة عشر عامًا، أهدتني صديقة فلسطينية من غزة نسخة من رواية جان جينيه سجين الحب. كانت هدية عيد ميلادي التي تأخرت سنة تقريبًا عن موعدها، وهي حقيقة عالقة في ذهني لسببين. الأول هو أنه عندما ناولتني صديقتي الكتاب في حديقة منزلها المشترك في إزلنغتون، أتذكر كيف كان دفء الشمس الدافئ يبعث في نفسي شعورًا بالشباب والوعود في ذلك الوقت المبكر من الصيف تحديدًا، بينما عيد ميلادي في أواخر أيلول/سبتمبر.
السبب الثاني الذي يجعلني أتذكر تأخر الهدية هو أنني عندما ناولني صديقي الكتاب في العام 2010، قربت صفحاته من أنفي - كما أفعل مع كل شيء تقريبًا، ولكن بشكل خاص الكتب - واستنشقت بعمق. انبعثت رائحة سجائر ميتة قوية من الصفحات التي لم تُمس. كان الكتاب موجودًا في غرفة نوم صديقتي لأشهر عديدة، وهي مدخنة تقضي أيامها في لندن - عاطلة عن العمل وبلا تصريح عمل، وغير قادرة على العودة إلى غزة بعد الحصار الإسرائيلي - مستلقية على السرير تدخن وتقرأ.
قالت: "أعتقد أن هذا سيعجبك".
في ذلك الوقت، لم أكن قد سمعت عن جينيه في ذلك الوقت، وشرحت لي هذه الصديقة - الجادة والمثقفة والمغايرة جنسيًا - أن جينيه كاتب مسرحي وروائي فرنسي مثلي مشهور، كان عامل جنس سابقاً ولصًا صغيرًا تحول إلى شخصية أدبية شهيرة. في أوائل السبعينيات، أمضى جينيه وقتًا مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية - الفدائيين - في الأردن، أيام قليلة امتدت إلى عدة سنوات وأشعلت التزامًا استمر طوال عمره بالقضية الفلسطينية. أسير الحب كان كتابه الأخير - وهو عبارة عن مجموعة من ذكرياته عن تلك الفترة، ممزوجةً أحيانًا بأفكاره عن الفترة التي قضاها مع الفهود السود في الولايات المتحدة.
وأنا ممسك بالكتاب السميك بين يدي، فهمت حينها سبب إهداء صديقي له. كان هذا في ذروة هيمنة الغسيل الوردي الإسرائيلي، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تسوّق نفسها بقوة على الساحة العالمية كمنارة لحقوق المثليين، في عرض إيمائي لليبرالية الغربية مقابل صورة العالم العربي المتداولة كظلها المتخلف والمعادي للمثليين. بالنسبة للفلسطينيين الكويريين، كان هذا هو الوقت الذي استُخدمت فيه هويتنا كسلاح ضدنا، عندما كان حتى بعض أقرب رفاقي المناهضين للإمبريالية ينظرون إلى مثليتي الجنسية بنوع من الريبة. وهكذا كان وجود الكتاب يخدم غرضًا مهمًا. هنا كان هناك رجل مثلي يكتب بحميمية وشغف - ومن منطلق من منظور عن الثورة الفلسطينية. حتى من دون أن أقرأه بعد, سجين الحب كان أحد أول التأكيدات التي حصلت عليها بأن كويريتي والتزامي بالتحرر الفلسطيني لا يمكن أن يكونا جنبًا إلى جنب، بل هما في الواقع متشابكان بشكل معقد.
بعد بضعة أشهر، أخذت سجين الحب معي في رحلة برية من لبنان إلى جنوب الأردن، مرورًا بالعديد من البلدات الشامية التي ذكرها جينيه في الكتاب: درعا، وعجلون، وإربد. كان الكتاب شاعريًا ومعقدًا ومتعرجًا ومفككًا، وكان رفيقًا موثوقًا وإن كان صعبًا أثناء الرحلة. يتجنب جينيه السرد والقصة والزخم، ويختار بدلاً من ذلك ذكريات وتأملات مبتورة تنزف وتحترق مندمجة في بعضها البعض، وترتد عبر الزمان والمكان.
على الرغم من أن أحداث الكتاب تدور في المقام الأول في العامين اللذين قضاهما جينيه مع الفدائيين في مخيمات اللاجئين بين 1970 و1971، إلا أنها ليست كذلك حصريًا بأي حال من الأحوال. يمكن أن تبدأ جملة واحدة في زمان ومكان واحد وتنتهي بعد عقد من الزمن في مدينة تبعد مئات الأميال. يكتب إدوارد سعيد واصفًا قراءة سجين الحب: "هي قبول خصوصية حساسية [جينيه] غير المستأنسة تمامًا، والتي تعود باستمرار إلى تلك المنطقة التي ترتبط فيها الثورة والعاطفة والموت والتجدد."
كنت قد قرأت أقل من نصف سجين الحب عندما عدت إلى لندن، وسرعان ما أعدت الكتاب - من دون أن أنهيه - إلى رف كتبي، حيث ظلّ قابعًا على مدى السنوات الأربع عشرة التالية. على الرغم من أنني لم أستطع أن أتوقع متى سيعود سجين الحب إلى قمة كومة كتبي التي كنت أقرأها باستمرار، إلا أنني احتفظت بالكتاب. وبمرور الوقت، بدأت أشعر أن الكتاب قد عفا عليه الزمن، فالغضب الذي أتذكره يتسرب من خلال الحبر على صفحاته يعكس الغضب الكئيب الذي كان سائدًا في نهاية حياتي بدلاً من غضب الشباب الذي دفعني إلى الحركة خلال الربيع العربي. لم أتذكر من الكتاب سوى ذكريات غامضة عن أم وابنها - حمزة - الذي كان جينيه مفتونًا به، وربما مغرمًا به.
على مر السنين، كنت أحيانًا ألتقط نسختي وأتصفحها. كانت رائحة الدخان العالقة تثير ذكرتين متجاورتين مثل مشهدين من فيلم منزلي: الأولى، قراءة الكتاب وأنا محشور بين الغرباء في المقعد الخلفي لسيارة أجرة مليئة بالدخان خلال رحلتي البرية عبر بلاد الشام، والثانية، حديقة صديقتي يوم أهدتني الكتاب، حيث جلسنا ندخن السجائر ونتحدث عن الثورة وفلسطين بكل حماسة شبابنا العاجز. في كلتاهما، كان دخان السجائر حاضرًا بقوة، نفس الرائحة التي ظلت عالقة بين صفحات نسخة كتابي كرائحة الثورة العنيدة. ارتبطت تلك الرائحة بالكتاب لدرجة أنني عندما كنت أمسك بالمصادفة نسخًا أخرى حول العالم، كنت أتفاجأ بأن رائحة سجائر صديقتي مارلبورو ريدز التي انطفأت منذ زمن لم تفح منها.

يشير توقيت تأليف الكتاب إلى أن رؤية جينيه لمجزرة صبرا وشاتيلا - حيث قامت قوات الكتائب اللبنانية تحت إشراف الجيش الإسرائيلي بذبح الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين الشيعة في مخيمين للاجئين في لبنان - حفزت التدفق المفاجئ للذكريات التي شكلت الكتاب. ولكن في سجين الحبلا يغوص جينيه في تفاصيل المذبحة (وبدلًا من ذلك وردت تأملاته المحددة حول المذبحة في مقاله المؤثر أربع ساعات في شاتيلا). ربما، عندما يكون الرعب كبيرًا جدًا، هناك راحة تتمثل في العودة إلى الماضي الذي يسمح بمسافة آمنة يمكن من خلالها مراقبة الحاضر. ربما لهذا السبب أيضًا، وسط الرعب الذي لا يوصف الذي يتكشف في فلسطين في شتاء 2023 الأسود، وجدت نفسي أسحب سجين الحب من على الرف.
أمسكت الكتاب بيديَّ، وفعلت ما أفعله دائمًا: قربته من أنفي واستنشقت بعمق. كنت أتوقع أن تهاجمني رائحة دخان السجائر، ما أثار ذكريات تلك الرحلة على الطريق، ورائحة صديقتي ومحادثاتنا. لكن رائحة السجائر اختفت. ليس ذلك فحسب، بل عادت رائحة الكتاب بشكل مفاجئ لتذكرني برائحة "الكتاب الجديد" الغامضة تلك، على الرغم من أني حملته معي عبر قارات متعددة على مدى العقد ونصف العقد الماضي. كنتُ قد ربطت رائحة الدخان تلك برائحة صديقتي الغزاوية تلك، بفلسطين، وكأنّ أيًا منهما لم يكن موجودًا على الإطلاق، وكأنني ببساطة تخيلت الأمر برمته. ملأتني الفكرة بحزن رهيب ورعب وجودي غير متوقع. فالزمن هو العدو الأكبر للفلسطينيين، كم هو عدو عنيد هذا العدو، وكم هو قويّ هذا العدو، يمحو حتى أكثر الروائح عنادًا، وأكثر الناس عنادًا.
على مدار شتاء 2023، قضيت أيامي في قراءة سجين الحب. كانت تجربة قراءة خواطر جينيه تشبه التحديق من نافذة قطار فائق السرعة يتسابق عبر مشهد من التاريخ. إن محاولات تسجيل كل جملة أو لحظة أو حادثة مذكورة في هذا الكتاب الكثيف المتعرج بدقة ليست مستحيلة فحسب، بل إنها تفتقد إلى الغاية. لا يمكنك أن تعثر على أجزاء سردية كبيرة في هذا الكتاب المكون من حوالي 500 صفحة والذي يتحدى النوع الأدبي، فهو ليس مذكرات أو رواية أو مقال ينتمي إلى الصحافة السياسية أو حتى كتاب رحلات. بدلاً من ذلك، من الأفضل أن تدع شلال الذكريات والتأملات يتدفق عليك. بعض التضاريس دنيوية ومتعرجة ومتكررة، وهي قراءة مؤلمة. ولكن بعد ذلك، تقفز صورة أو جملة مضيئة بقوة عميقة لدرجة أنها تحرق نفسها في ذهنك، متوهجة وسط رطوبة الصور التي تسبقها وتليها، ثم ستحمل هذه الشعلة بداخلك لأيام.
وقد أشار جينيه إلى الكتاب على أنه مرآة للذكريات، ومن نواحٍ عديدة، سجين الحب يخبرنا عن مؤلف العمل أكثر مما يخبرنا عن موضوعاته. إنه يخبرنا عن علاقته بالكتابة، والبحث عن الحقيقة، والثورة، والذاكرة، وفي نهاية المطاف، التحرر والوحدة في حياة عاشها على الهامش بشكل دائم.
"هذه هي ثورتي الفلسطينية التي أرويها بالترتيب الذي اخترته. وبالإضافة إلى ثورتي هناك ثورات أخرى، وربما العديد من الثورات الأخرى. محاولة التفكير في الثورة تشبه الاستيقاظ من النوم ومحاولة رؤية المنطق في حلم ما".
في الواقع، قراءة التأملات السريالية والمتعرجة في سجين الحب - التي تدور أحداثها في زمن ثوري مفعم بالأمل في أوائل السبعينيات، حتى وإن كانت غارقة في الأحداث المأساوية التي وقعت في سبتمبر الأسود - على الخلفية المعاصرة للعنف الذي لا هوادة فيه والأكاذيب الجريئة والتمزق النهائي لوهم النظام العالمي العادل، تبدو وكأنها إعادة قراءة حلم. وكما الحلم، من الصعب إعادة سرده في أعقاب ذلك. تختفي الصور والشخصيات والأفكار تحت سطح الذاكرة.
أحد المواضيع الرئيسية التي تشغل جينيه في سجين الحب هو استكشاف قدرة اللغة على الوصول إلى نسخة من الحقيقة. ففي الصفحات الأولى، يقرّ جينيه بأن حقيقة الثورة الفلسطينية لن تجدها في محاولات وصفها، بما في ذلك محاولته هو. ويمضي رافضًا أي محاولة لقول الحقيقة الشاملة أو رواية "موضوعية" شاملة يمكنها أن تلتقط حقيقة واحدة:
"لو كانت حقيقة الوقت الذي قضيناه بين - وليس مع - الفلسطينيين موجودة في أي مكان، لكانت حية بين كل الكلمات التي تدعي أنها تقدم سردًا لها. يزعمون أنهم يقدمون سردًا لها، لكنها في الواقع تدفن نفسها بنفسها، وتضع نفسها بالضبط في المساحات، وتسجل هناك بدلًا من الكلمات التي لا تعمل إلا على طمسها".
في الواقع، يبدو جينيه في بعض الأحيان مستسلمًا - إن لم يكن مستمتعًا - للاعتقاد بأن الكتابة ليست أكثر من خيانة. "بمجرد أن نرى الحاجة إلى "ترجمة" الحاجة الواضحة إلى "الخيانة"، سنرى إغراء الخيانة كشيء مرغوب فيه، ربما يمكن مقارنته بالتمجيد الإيروتيكي".
كيف يمكن قراءة ذلك في سياق النضال الفلسطيني المعاصر لتخصيص كلمات وتصنيفات للعنف الذي لا يُوصف في غزة؟ الكلمات واللغة والرواية هي آليات لنشر السلطة. لقد أمضى الفلسطينيون عقودًا في تعلم لغة القانون الدولي وحقوق الإنسان. لكن الأحداث التي وقعت منذ أكتوبر 2023 أوضحت أن اللغة وحدها لا تكفي. فالكلمات، مهما كانت متماسكة ومدققة في الحقائق والسياق، يمكن أن تخوننا فجأة.
كان لانعكاسات جينيه حول خيانة اللغة صدى عميق عندما كنت أشاهد الفظائع التي تطلقها آلة الموت الإسرائيلية، وهو عنف قاسٍ ووحشي لدرجة أنه طغى على أكثر الروايات الخيالية بشاعة. وكلما اعتقدت أنني ربما أكون قد اعتدت على العنف، ظهرت صورة أو مقطع فيديو مفاجئ ليجعلني عاجزًا عن الكلام، أو يدفعني إلى موجة من المشاعر - موجة من الحزن والغضب والعجز - تمتد من أعماق معدتي وتتسرب إلى صدري وذراعي ورقبتي وساقي.
وحتى عندما تم رفع هذه الفظائع إلى أعلى المستويات في المحاكم الدولية في محاولة يائسة لتخصيص كلمات لهذا العنف، وبنفس السرعة التي تم بها تخصيص فئة لوصف الرعب لمعاناة الفلسطينيين، تم تجريدها فجأة من أي معنى أو قوة.
في فبراير 2024 أشارت الروائية الفلسطينية عدنية شبلي إلى أنه "في فلسطين/إسرائيل، يكبر المرء وهو يدرك أن اللغة أبعد من كونها أداةً تُستغلّ للتواصل أو الحكي. يمكن مهاجمتها، ويمكن أن تُهاجم، ويمكن أن تُكسر، ويمكن أن يُساء استخدامها. والسؤال هو، كيف يمكنك أن تثق باللغة عندما تسبب لك الألم أيضًا، وعندما تتخلى عنك، وعندما يتوجب عليك أن تواجه القسوة وحدك، بلا كلام؟"
في ظل الرعب الذي يتكشف أمامنا، تبدو اللغة والكلمات غير مهيأة للتعبير عن ضخامة الحزن والخوف أو المساعدة في التقليل من فداحة الحزن والخوف. فالأمر يشبه حرفيًا استخدام قلم في معركة بالأسلحة النارية.
إن القوة المتناقضة للكلمات والسرد هي موضوع متكرر في تأملات جينيه. في فقرة كُتبت قبل أكثر من أربعة عقود، لكن يمكن كتابتها اليوم تقريبًا كما كُتبت كلمةً كلمةً، يكتب جينيه عن الحرب التي تشنها إسرائيل في عالم الكلمات واللغة:
"ذكاء شديد من إسرائيل في نقل الحرب إلى قلب المفردات، وإضافة كلمتي المحرقة والإبادة الجماعية. إن غزو لبنان لم يجعل من إسرائيل معتدية أو غازية. لم يكن الدمار والمجازر في بيروت من فعل إرهابيين سلحتهم أمريكا وألقوا أطنانًا من القنابل ليلاً ونهارًا لمدة ثلاثة أشهر على عاصمة يسكنها مليونا نسمة: لقد كان فعل رب بيت غاضب يملك القدرة على إنزال عقاب شديد بجار مزعج. الكلمات فظيعة، وإسرائيل متلاعبة مرعبة بالإشارات. فالعقوبة لا تسبق بالضرورة الإعدام، فإذا ما تم تنفيذ حكم الإعدام، فإن الحكم سيبرر تدريجيًا. عندما تقتل شيعيًا وفلسطينيًا، تدّعي إسرائيل أنها طهرت العالم من إرهابين في آن واحد".
وهناك تلك الكلمة، "إرهابي"، التي سبق أن التقطها جينيه ليفحصها قبل أربعين عامًا. وكعربي، وكفلسطيني، شاهدت على مدار حياتي هذه الكلمة تترسخ في ذهني. في مراحل مختلفة، كثيرًا ما كنت أتأمل في عقود من الدعاية العالمية المعادية للسامية التي سبقت الإبادة الجماعية النازية، وأتساءل، بغموض، عما إذا كانت عقود الإسلاموفوبيا ستبلغ ذروتها في نفس النوع من الإرهاب. كنتُ أؤكد لنفسي أن هذا هراء، وكنت أتخلص من مثل هذه الأفكار باعتبارها أوهامًا بجنون العظمة. العالم الآن مكان مختلف تمامًا عما كان عليه في منتصف العشرينيات من القرن الماضي. إلى جانب ذلك، أين ستحدث مثل هذه الإبادة الجماعية؟ وأي مجموعة من العرب والمسلمين ستقع عليها فأس عقود من التجريد من الإنسانية؟ كان يجب أن أعرف حتى في ذلك الوقت أنها ستكون فلسطين، القلب النابض للعالم الحديث بكل ما فيه من جمال ورعب.
هناك صدق لا يتزعزع في سجين الحب، مخيف ومنعش في آن واحد. وكما كان جينيه غير مثقل بأداء الموقف والصواب السياسي المتوقع من الكتاب المعاصرين، فإنه يضع نفسه بلا اعتذار في مركز عمله الخاص. بالنسبة لكاتب فرنسي أبيض البشرة غالبًا ما كان يطعّم كتاباته بالجنس والإثارة الجنسية، كنتُ مستعدًا لمواجهة مذكرات مليئة بالصور الغرائبية والاستشراقية. في النهاية، لم أصادف حالات خطيرة من أي منهما. لم يكتب جينيه في أي مرحلة من المراحل عن الفلسطينيين من موقع سلطة، ولم يكن في أي مرحلة من المراحل في خطر "التحوّل إلى مواطن". وبينما تتسرب بين الفينة والأخرى حالات من كراهية النساء الصارخة عبر الصفحات، إلا أن التعاطف والحب الحاد ينبضان في كلماته طوال الوقت. لا يوجد أي تخمين ثانٍ، ولا خوف من الإلغاء، فقط صدق وحب صريحان مثيران ومريحان في آنٍ واحد.
ومما لا شك فيه أن جينيه كان يحب العرب وخاصة الفلسطينيين. فبينما كان يعرض المقاومة الفلسطينية بنعومة شبه حزينة، وكثيرًا ما يشير إلى طبيعة الفلسطينيين اللطيفة والمسالمة أكثر من اللازم، الذين يهتمون بحدائقهم وأزهارهم أكثر من اهتمامهم ببنادقهم، فإنه يرى الفهود السود في ضوء مختلف، كحركة أكثر قوة وإثارة ولكن في النهاية أكثر وعيًا بالصورة، حركة مشغولة بفرض استفزاز أسلوبي لأمريكا البيضاء أكثر من انشغالها بفرض تغيير سياسي ملموس وقابل للتطبيق:
"ارتداع البيض من أسلحة الفهود، وستراتهم الجلدية، وتسريحة شعرهم الثورية، وكلماتهم وحتى لهجتهم اللطيفة ولكن المهددة، كان هذا بالضبط ما أراده الفهود. لقد تعمدوا خلق صورة درامية. كانت الصورة مسرحًا لتمثيل مأساة ما ولإخمادها، مأساة مريرة عن أنفسهم، ومأساة مريرة للبيض. كانوا يهدفون إلى إبراز صورتهم في الصحافة وعلى الشاشة حتى يطاردهم البيض. وقد نجحوا في ذلك. كانت الصورة المسرحية مدعومة بموت حقيقي. فقد قام الفهود بإطلاق النار بأنفسهم، ومجرد رؤية بنادق الفهود جعل رجال الشرطة يطلقون النار. هل كان فشل الفهود يرجع إلى حقيقة أنهم تبنوا صورة العلامة التجارية قبل أن يكتسبوها في الحراك؟"
وفي الوقت نفسه، قام الفلسطينيون بثورتهم على المسرح العالمي لأغراض مختلفة قليلاً. إذ يستشهد جينيه كثيرًا بخطاب ياسر عرفات أمام الأمم المتحدة في العام 1974، حيث كان ظهور الفلسطينيين جزءًا لا يتجزأ من الصراع من أجل البقاء:
"أوروبا وبقية العالم يتحدثون عنا ويصوروننا ويجعلوننا موجودين. لكن إذا توقف المصورون عن المجيء، وتوقف الراديو والتلفزيون والصحف عن الحديث عنا، ستعتقد أوروبا وبقية العالم أن "الثورة الفلسطينية انتهت. لقد حسمت أمريكا وإسرائيل الأمر بينهما"".
السياسة كمسرح هي فكرة متكررة. في أحد المشاهد المبكرة في سجين الحب يحكي جينيه مشهدًا راقصًا في مرحلة ما بعد الاستعمار بين الجيش البدوي الأردني والفدائيين الفلسطينيين، حيث يكيل الأردنيون المديح لملك الأردن، ويرد الفلسطينيون بمديح ياسر عرفات. هنا، كان الأداء هو القناة التي يؤكد من خلالها كل طرف ولاءه الوطني: "كان الرقص عرضًا، بل شبه اعتراف، بالأنوثة التي تتناقض بشدة مع صدورهم الممتلئة". في وقت لاحق، في بيروت، يقوم جاسوسان إسرائيليان بعملية اغتيال تحت ستار أداء كويري، "وأذرعهما حول أعناق بعضهما البعض، يضحكان ويتبادلان القبلات". وعندما يصيح الحراس في وجهيهما بالشتائم، يشهر "الكويريان المروعان" مسدسيهما ويطلقان النار على الحراس ويقتلانهما. يتأمل جينيه في البروفات التي لا بد أن يكون الرجلان قد قاما بها لتنفيذ هذا الأداء، وكيف تدربا على "جعل مداعباتهما معقولة... كان عليهما أن يعتادا على القبل، على تقبيل الفم [...]. عضلات ذراعيهما وساقيهما، وخفة حركتهما، وبراءة وجهيهما وخلوهما من الشعر، كل ذلك كان يجب أن يكون في غاية الكمال".
ولكن بالنسبة للفهود والفلسطينيين على حد سواء، فإن الأداء هو أيضًا فعل تعطيل وتحدي للروايات المهيمنة التي تزدهر على الموت أو الاختفاء الدائم: من ناحية، أسطورة أمريكا البيضاء، ومن ناحية أخرى، أسطورة إسرائيل كأرض الميعاد اليهودية.
يعد إدراج الفهود السود في كتاب عن فلسطين اختيارًا مناسبًا. فثمة تاريخ طويل من التضامن بين نضال الأمريكيين السود والنضال الفلسطيني لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا. وقد جاء مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة في نفس الفترة التي شهدت مقتل الطالب إياد الحلاق البالغ من العمر اثنين وثلاثين عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية المحتلة. وليس من قبيل المصادفة أن الحلاق قُتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن بعد أن هتف "حياة السود مهمة" و"حياة الفلسطينيين مهمة"، وفي تزاوج ملائم بين الحركتين، فإن الشخصية المتكررة في ذكريات جينيه هي مبارك، الفدائي الفلسطيني الأسود. في إحدى المحادثات، يتأمل مبارك كيف يشعر الفدائي الفلسطيني بعرقه، حيث يقول لجينيه: "لا يمكننا أن نكون موجودين من خلال ذكائنا. لا يمكننا أن نقول أننا موجودون إلا من خلال الدخول تحت جلود الآخرين"، يبدو هذا صحيحًا بالنسبة لسواد مبارك وفلسطينيته على حد سواء.
أفضل ما يلتقطه جينيه هو الغرابة في قلب كلتا الحركتين. وهذه الغرابة هي أكثر ما يأسر جينيه. وقد سمح الانتماء إلى كلتا الحركتين لهذا الأديب الذي كان منبوذًا في يوم من الأيام بالحفاظ على انحيازه إلى الهامش. ويكاد جينيه نفسه يعترف بذلك:
"هل كانت الثورة الفلسطينية ستمارس هذا الانبهار الشديد بي لو لم تكن قد قامت ضد شعب بدا لي أنه أظلم الشعوب؟ شعب ادّعى أنه البداية، وادّعى أنه كان، وقصد أن يبقى، هو البداية، وقال إنه ينتمي إلى فجر التاريخ؟ أعتقد أن طرح السؤال هو الإجابة عنه. لم تكن الثورة الفلسطينية، التي جرت على خلفية فجر البدايات، معركة عادية لاسترداد الأرض المسلوبة، لقد كانت صراعًا ميتافيزيقيًا. كانت إسرائيل، التي فرضت أخلاقها وأساطيرها على العالم أجمع، ترى نفسها متطابقة مع السلطة".
وكما يفترض جينيت، فإن المأزق الفلسطيني ليس فقط ضد الأفكار الغربية لبناء الأمة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل ضد أوامر الله ذاتها، أي ضد المرسوم التوراتي الذي ينص على أن أرض فلسطين كانت لليهود. هل هناك ما هو أغرب من صراع يسعى لإسقاط كلمة الله نفسه؟
وأكثر من ذلك، هل هناك ما هو أكثر غرابة من ثورة لم تتحقق بعد؟ كتب جينيه أسير الحب في فترة من الحيرة والحزن في حركة تحرير فلسطين. ففي ظل مذبحتي صبرا وشاتيلا والاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدا التحرير الفلسطيني بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. وقد استهوت هذه المراوغة جينيه المنبوذ الدائم والكاتب الذي كان يضع نفسه دومًا في حالة تمرد. لاحظ أحد الأصدقاء الذين قرأوا الكتاب معي أنه لو كان الفلسطينيون قد نالوا الحرية في حياة جينيه لكان قد خانهم لا محالة.
في تأملاته حول جينيه، يكتب إدوارد سعيد إلى ذلك في تأملاته حول جينيه مشيرًا إلى أن: "الأهم من الالتزام بقضية ما، والأكثر جمالًا وصدقًا، كما يقول [جينيه]، هو خيانة هذه القضية، وهو ما أقرأه كنسخة أخرى من بحثه المستمر عن حرية الهوية السلبية التي تختزل كل اللغة إلى مواقف فارغة، وكل الأفعال إلى مسرحيات مجتمع يمقته". يمكن فهم الهوية السلبية هنا على أنها هوية تتشكل في معارضة التوقعات المجتمعية؛ أي هوية كويرية تضع نفسها خارج كل شيء، مثل الجمهور الذي - بحضوره ذاته - يظهر كيف أن كل السياسة في النهاية هي أداء، وكل الثورات مجرد مسرح.
على الرغم من هذا التوتر من الخيانة، وربما بسببها، فإن ما يظهر من تأملات جينيه هو صورة إنسانية للنضال الفلسطيني نفسه. وهذا السرد للنضال الثوري الفلسطيني هو ما يبدو مهمًا في هذه اللحظة التاريخية بالذات، حيث المحاولات القليلة لرسم صورة "إنسانية" للفلسطينيين تفعل ذلك من خلال صورة الضحية، وتجريد الفلسطينيين من نضالهم الثوري لجعلهم أكثر استساغة - أقل قابلية للقتل - للعالم. وبالفعل، غالبًا ما يتم تخيل غزة اليوم إما كموقع "إرهاب" إسلامي أو كموقع معاناة ويأس إنساني. ما يُنسى غالبًا عن هذا الشريط الصغير من الأرض على البحر الأبيض المتوسط هو أنه أيضًا مهد الكثير من المقاومة الفلسطينية، سواءً أكانت مقاومة عنيفة أو سلمية.
إن الصورة التي رسمها جينيه للفلسطينيين ليست مجرد احتفال بفلسطين بل هي احتفال بثورة فلسطين والنضال العنيف أحيانًا من أجل التحرر الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية. ولكن، كما يشير الباحث ستيفن شيهي في تأملاته حول طرد إدوارد سعيد من جمعية فرويد في فيينا في 2001 - عقب ظهور صورة لسعيد وهو يقذف حجرًا على برج حراسة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان - "إن الإنسانية العالمية لما يسمى بالديمقراطيات الغربية الليبرالية لا تتسع لإنسانية العالم، ناهيك عن الإنسانية العالمية المتحدية للفلسطينيين".
جينيه، على النقيض من ذلك يركز هذه الدنيوية الجريئة. في الواقع، هذا هو الحب الذي يتحدث عنه في العنوان، ليس حبًا موجهًا للفلسطينيين - رغم أنه لا شك في ذلك - بل لثورتهم ونضالهم من أجل تحرير بعيد المنال لم يتحقق بعد، والذي يبقى - لنستعير تعريف خوسيه إستيبان مونيوز للغرابة ونعيد صياغته - "إضاءة دافئة لأفق مشبع بالإمكانية". إن التحرر الفلسطيني موجود بالنسبة لنا كمثالية "يمكن استخلاصها من الماضي واستخدامها لتخيل مستقبل جديد".
أتاحت لي قراءة جينيه وأنا أشهد على الفظائع التي تتكشف في الحاضر، والصور التي لا حصر لها للأطفال القتلى والآباء المفجوعين والأطراف الممزقة والوجوه التي يغطيها السخام، مساحة مقدسة للتأمل والتذكر، لأستعيد زمنًا مضى عليه نصف قرن، عندما كان كاتب فرنسي كويري شاهدًا على لحظة زمنية مختلفة، لحظة تحمل بذور الأمل التي تحتفي بالنار الثورية التي عاشت - ولا تزال تعيش - داخل الشعب الفلسطيني. شعرتُ بقربي الحميم من فلسطين، ليس فقط كأرض جغرافية بل كمفهوم ثوري ونضال ضد الاستعمار بكل تناقضاته وفروقه الدقيقة، بجماله وإحباطاته، بصوابه وسذاجته القاتلة.