ظل مقهى «ستراند» في باب اللوق بالقاهرة مكانًا لتجمع الفنانين والكتاب والصحفيين لسنوات عديدة، على الرغم من ذلك، سيغلق المقهى أبوابه قريبًا، أثار الخبر موجة من الاستياء المستسلم في أوساط المثقفين القاهريين. تكتب هبة حافظ عن المقهى، وتحكي عن لحظات مؤثرة اختبرتها فيه، ويبقى سؤالها الأخير بلا إجابة.
كأنك تودع ذلك الرفيق العزيز الغالي، صديقًا ظل حيًا وفيًا سبعين سنة، ثم فجأة قرر أن يغلق عينيه إلى الأبد ويترك لك ذكريات صامتة، عارية من حضوره.
صديقًا كنت تقصده على مدار سنين معرفتكما، لتستقطع وقتًا لنفسك فقط، لأنه يسمح بذلك، يعطيك ذلك الإحساس من الخصوصية حتى وأنت في مكان مفتوح وفي الشارع، لكن يعطيك كل الخصوصية.
تعالي فضفضي لي بما يؤلمكِ، سأنصت جيدًا، سأربِّت على كتفك وهم يعدون لك ينسونًا ساخنًا، ستشربينه وتنسي، أسمعتِ نجاة تشدو، أو فوزي يطرب؟ سأغسل روحكِ وقلبكِ وعقلكِ، واجعلكِ تغادرين سعيدة.
مقهى «ستراند» في باب اللوق لم يكن مجرد مقهى، كان شباكي الأجمل الذي أطل منه على زمن كامل، زمن عشته وزمن لم أعشه، مكان صغير لكنه مجرة مضيئة تسبح وحدها، تتسع لعوالم الكتابة والفن والشعر وغيرها كثير، المكان مزدحم بكل الطاقات والأفكار والضحكات والترهات والتأملات والتفاهات واللعب والبدايات والنهايات.
ذلك كاتب يكتب على منديل، وهناك شاعر يكتب على يده، وفنان آخر يتخيل دخان سيجارة جاره الجالس لوحة فنية لباليرينا ترقص في المكان، وناشط يرسم خريطة للوطن من غير حدود في عيون حبيبته، وعاشق ينظر إلى القهوة التي ملأت رائحتها المكان، لكن جل ما يشمه الآن هو رائحة معشوقته.
لا، هو ليس كمجرة، ظلمته حتى لو كان في فضاء شاسع، على الأرض دوره أعمق بكثير، إنه مسرح كبير عتيق، تجلجل في جوانبه أصداء الأصوات.
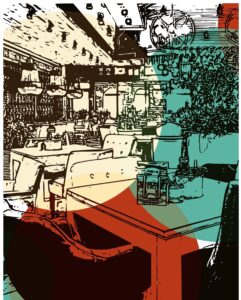
نجلس على مقاعده الخشبية، نبدل أدوارنا، تارة مع كل فنجان قهوة، وتارة مع كل أغنية تلو الأخرى، وتارة مع مشروب مختلف مثل الينسون أو العنَّاب، وتارة مع ناس آخرين، وتارة مع نفسي لكنها نفس أخرى. طول الوقت نبدل الأدوار.
تنظر إلى الحائط فتسمع همسًا قديمًا من ثمانينات القرن الماضي، يتكلم ويرد ويعارض. تنظر إلى المروحة فترى أحلامًا راحت، ووعودًا انفرطت كحبات مسبحة خشبية فصنعت الكراسي الخشبية.
تدخل المقهى وتعرف جيدًا ما يناديك، كرسي أم حائط أم لوحة، في ستراند لم نكن قط زبائن، بل كنا شخصيات في حكايات وقصص ودراما على مسرح كبير.
حين تدخل ستراند لا تسأل عما يناديك؛ كرسي، حائط، أو لوحة.
هناك، لم نكن يومًا مجرد زبائن، بل كنا جزءًا من مسرحه الكبير.
وأحيانًا، كنت أنت نفسك الكرسي تحمل أثقالًا، أو ذلك الحائط الذي يصغي للهمس، أو لوحة زرقاء تلتقط بقايا النظرات.
في ستراند تتمنى أن تقترب من الآخرين بذلك القرب الحميمي الصامت، حتى لو أن تكون خشب نافذة يتكئ عليه رأس مثقل بالتعب، فيترك عليك أثره، ويمنحك سر قربه.
سبعون عامًا وهو قبلة لأي شخص ولكل شئ، حتى قطط وسط البلد وعابدين وباب اللوق.
الآن ينسحب ستراند من كل تلك المشاهد التي ملأت كل لحظات السنوات السبعين الماضية، يغلق الستار على أصوات كل رواده.
المسرح لم يكتمل، والجمهور تجاوز أضعاف مساحة القاعة، غاب الذي كان شاهدًا على زمن وحكايات وحواديت ونظرات، كلها واقفة عند لحظة بعينها تُعاد وتُعاد.
ممر ستراند، بضوئه الخافت الذي ينساب كأنفاس هادئة، يلامس وجوهًا قديمة قدم المكان ويستقر فوق لوحاته الزرقاء. كانت نجاة تغني: «حقك عليا»، وبعدها فوزي: «حبيبي وعنيا»، أحب الاثنين. أعرف أن الساعة تقترب من الثانية عشرة، لحظة الإغلاق المعتادة.
بدأت أجمع بقايا مناقشات ومشاحنات اليوم؛ عتاب هادئ، ضحكات وابتسامات… لحظة الصمت الأخيرة بابتسامة كانت كفيلة بأن تغسل كل شيء، أغلق الليل بابه على طمأنينة وأشرقت الشمس على غيرها.
ظل لقائي بك عالقًا هناك، على نفس المقعد الخشبي الذي لا يزال يتذكرني. ظللت أعود إليه، اتنقل حوله بين المقاعد الفارغة، أبحث… كل مرة أبحث، كأنني سأجده، أو يجدني.
والآن، يظهر سؤالي الذي أحاول الإجابة عنه؛ ماذا أفعل بكل هذا الحنين… إلى ستراند؟





